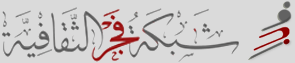قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الهداية والإضلال

الضلال كلمة تفيد الابتعاد عن الهدى والصواب، بل تعني التيه وإضاعة الطريق، وهو ليس مجرد خطأ قد يقوم به إنسان ما، بل إنه إرادة التيه، ومجانبة الهدى والصواب عن إرادة واختيار، أو انغماس في الضلال، بحيث يصبح مسار حياة وعقلية الضال الذهنية والنفسية، ومن صور الضلال التي استعرضها القرآن، وعلى رأسها الشرك بالله، فهو والمعاندة بالباطل أشد صور الضلال المتخيلة.
وقد يبدأ بمسار خاطئ عند بعض من انحرف في العمل والاعتقاد، بحيث يصبح في ناتج الأمر ضلالًا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾[1] وهنا إشارة إلى أنه في الناتج الوقوع في الخسارة الكبرى بفعل السنّة الإلهية وعقاب الله لهم. لذا، ينبغي أن يبقى حاضرًا في الذهن أن الحال النفسي للضال هي غالبًا العناد والجحود والتيه والجهالة. وبما أننا هنا نود استعراض الموضوع من الوجهة الإسلامية، فسنعمد لقراءته على ضوء المستفاد من بعض آيات سورة محمد (ص)، ومنها:
﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾[2]
هنا سببان: أحدهما عقائدي وهو الكفر، والآخر أخلاقي وهو منع الناس، وقمع حريتهم الدينية أو القيام بتشويه وإزاغة نظرتهم للحياة، بحيث يتم منعهم عن إرادة اتباع طريق الله سبحانه. وكلا السببين تعلمك الآية معهما على أنهما مواجهة مع الله. لذا، جاء في ذيل الآية بيان أن الله سبحانه هو الذي أضل أعمالهم. إلى هنا من الواضح وجه الفعل والدافع إليه والتصدي له، لكن الذي يحتاج إلى بيان:
أولًا: المقصود من الكفر ولأي صنف ومستوى ينتمي؟ هل هو كفر بأمور حملتها رسالة النبي؟ أم أنها تعبِّر عن رفض أصل الرسالة النبوية دون أي معرفة بها؟
ثانيًا: الصد عن سبيل الله، هل هو أي فعل مانع للسير على خطى طاعته سبحانه؟ أم أنه مشروع يحمل أهدافًا وإجراءات وآليات عمل تحقق حسب افتراض الكافر إلى تحقيق هدف محدد هو الصد عن السبيل؟
ثالثًا: بأي نحو يضل الله أعمالهم؟ هل على نحو مباشر؟ أم وفق مسار السنن التي رسمها الله لمثل هذا الأمر؟ وما هو دور الإنسان في كل ذلك؟
حتى أكون واضحًا من طابع السؤال الأول، فإن مقصودي أن مسألة التنكر لأي دين ومنه الإسلام، إما أن يكون مبدئيًّا ومن أصل الرسالة كما في كثير من الحالات التي تحصل، أو أن يكون من عموم أو تفصيل، ولو تفصيل ما في دين معين، وهنا نتحدث عن الكفر بالإسلام. والنحو الأول هو غالبًا نفسي، وأحيانًا يكون بسبب اختلاف أيديولوجي أو ديني استدعى ذلك. فتصبح خصومته خصومة معدة ومركبة من جهل وعصبية. أما في الحالة الثانية فلأسباب تتصل غالبًا بالموقف العقائدي وخصوصياته، أو بسبب تشريع لا ينسجم مع طبع الرافض له فيكفر به.
وبالحالتين، لا يكتفي الرافض بميله وطبعه أو حدود موقفه، بل هو يتعداه لموقف عملي إقصائي ينم عن كراهية وسوء سريرة، وهو الذي أسماه القرآن بالعمل على “الصد عن سبيل الله”، وهذا تعبير عن قرار وإرادة فعل ورسم ظروف وتحيّن فرص، واستخدام استراتيجيات وإجراءات مضنية منها ما يمكن أن يكون عبر الخشونة والمواجهة، ومنها ما يمكن أن يكون عبر الأساليب الناعمة والمكائد الثقافية والاجتماعية، ونشر فوضى الأخلاق وثقافة التفاهة والتشكيك بكل شيء لأجيال من أهل الإيمان.
ولعل الهدف كما الإجراء الأهم عند هؤلاء يتمثل بأمرين:
الأمر الأول: الانحراف الفكري، وبالتالي السلوكي.
الأمر الثاني: فهو ممارسة مستويات عالية من الاستنزاف النفسي لأصحاب القضايا الإيمانية، لإلحاق الهزيمة بمقتضيات ومواعيد إيمانهم من جهة، ولتخويفهم من عدوهم خوفًا خانقًا، من جهة أخرى.
هؤلاء ينص كلام المولى سبحانه أنه سيضل أعمالهم. أي التيه والخذلان في تحقيق الأهداف هو الذي سيصيبهم وسيكتب لهم. من باب أن قاصد الشر ينقلب عليه شرّه.
وغالبًا، ما يحصل ذلك بفعل عاملين: العامل الداخلي لدى أهل عصبيات الكفر، بحيث لا تتوفر عندهم الاستعدادات اللازمة والوسائل المهيئة؛ رغم خطورتها، لتحقق الأهداف خاصة مع النموذج الإيماني لما له من خصوصيات نفسية ومعنوية، إما حصّلها بفعل خوضه معركة مواجهة الصد عن سبيل الله سبحانه، وإما بفعل الهوية الإيمانية الراسخة التي ينطلق منها بكفالة الله وهدايته، وهذا ما يمثل العامل الثاني لتبديد وإضلال جهد أهل الكفر.
فمن هؤلاء الذين أسماهم الله بالذين آمنوا؟
اصطفاف أهل الإيمان وقواعدهم
تذكر الآية من سورة محمد (ص) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾. إذن، هم ثلة من الرساليين آمنوا بالمشروع الإلهي التغييري الذي صدر عن الله سبحانه؛ أي إنهم تحزَّبوا حوله وصاغوا جماعتهم وفق هذا الالتزام، بحيث خرجوا على الناس خروجًا ثوريًّا ساعيًا لتحرير الناس مما هم عليه من قيم سلبية، ونمط حياة تحكمها قواعد وخصائص الدنيا والتثاقل إليها، وهو المعبّر عنه في بعض الآيات بحياة الظلمات.
يسعون لإخراج العالم والناس منها بعمل جهاديٍّ مضن، وأخلاقي صالح، وبناءات بديلة للمجتمعات تستطيع إخراج أهل الظلمات إلى رحابة نور الرحمة الإلهية والتحرّر. عليه، فالإيمان الأول المشار إليه بالآية هو إيمان الانتماء إلى المشروع الإسلامي التغييري.
أما الإيمان الثاني فبما جاء به رسول الله محمد (ص)، وهو الحق من ربهم، هو إيمان انسجام عقلي وقلبي بكل أمر أو حقيقة أو نموذج ومثال ورد في كتاب الله سبحانه الذي هو كتاب الهداية الباني لهوية ومضمون الشخصية الإيمانية ومجتمعها وحياتها. وهذا ما يمكن تسميته بإيمان الولاء.
وإذا ما كان إيمان الانتماء تعبير عن القناعة والإرادة التي حسمت خيارها الحياتي في التموضع بقلب الاستجابة لله في مواجهة الأحداث، فإن إيمان الولاء هو الباني والمؤسس للأفق المعرفي والمضمون النفسي والروحي للمؤمن. فإذا كان التزام الأوامر والنواهي والإرشادات القرآنية هي السلوك المعبِّر عن الولاء، فإن القيم وحضور الله الدائم والثقة به والنظر للحياة نظرة طافحة بما بعد الحياة الدنيا هي المدماك الصلب لتشكيل هذه الهوية لدى الشخص والجماعة.
إن مركزية المعنى في إيمانه هذا هو ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ الحق.. وإنه حق إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عليه، فالثلة أو الجماعة الإيمانية الولائية تمثل الصخرة التي يُبنى عليها المشروع الإلهي.
وهي القيادة الهادية لكل أصحاب إيمان الانتماء في صراعهم ضد الباطل وحفظ الذات المسلمة المؤمنة.
أما أين يقف الصواب، وأين يقف ما ليس بصواب؟ فبطبيعة الحال أن كل ما يعود إلى الله والاقتراب من يمثل في منطق القرآن حقًّا، وأن غير ذلك هو الباطل، وقد أكدت الآية على ذلك بقوله سبحانه حينما أشار إلى مرجعية ما أُنزل على النبي محمد (ص)، وأنه الحق من الله.. لكن يحسم القرآن الموقف اتجاه الجماعتين من حيث ملاك الحكم عليهما، وعلى مصيرهما بقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.
الملفت هنا، أن التدخل الإلهي في إحباط العمل أو إصلاحه لا يعود للكفر أو للإيمان، بل يعود إلى شأن السلوك العملي والمرجعية الثقافية والدافع لكل منهما، فالكافر لأنه اتبع الباطل بوجوهه المتنوعة الخشنة والناعمة لمحاربة الإنسان في أعظم ما يمثل كمالاته الإنسانية من التوجه إلى الله، قضى حكم الله على باطل الكافرين بأنه سيبطله، ومجرد إيمان المؤمن بمستوييه الانتمائي أو الولائي لا يكفي لإصلاح شأنه ونصرته، بل لا بدّ أن يعزّز ذلك بالعمل الصالح. سواءً من خلال مواجهة الفساد بجرأة، أو إشاعة مناخات الصلاح في المجتمع، أو غير ذلك من صنوف الجهاد، وبالشكل اللازم للعمل الصالح الذي لا يقتصر على البعد المعنوي، بل يتعداه إلى توفير كل الأدوات والخطط والمنهجيات اللازمة لتحقيق هذا الصواب في مواجهة الباطل، لمثل هؤلاء كتب الله أنه “أصلح بالهم”؛ أي وصلوا إلى حد الاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي، بفعل العمل الصالح الذي تتوفر فيه كل عناصر اليقظة الثورية الجهادية.
السنة الإلهية في إبطال الباطل
تطالعنا سورة محمد، الآيات 4- 9، بقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.
بوضوح ما بعده وضوح، طبيعة الموقع الإلهي هو عدم خرق أصل ما هي الدنيا عليه من ماهية في طبيعتها، ومن غاية لوجود دار اختبار وبلاء، فمن الصحيح أن أهل الإيمان هم أهل الحق، وأن معركتهم معركة مقدسة لكنها لن تُحسم بالإعجاز أو القهر الإلهي، ذلك أن الدنيا بصراعاتها دار بلاء.. لن ينتصر الله من الذين كفروا برغم أنه قال عنهم: “تعسًا لهم”. ولن ينتصر الله للذين آمنوا برغم أن معركتهم هي المعركة المحقة والصادقة؛ ذلك أن مقتضى تحقيقه للنصر إنما يكون على أيدي المؤمنين. ولذا، قال: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾. هؤلاء قتلاهم شهداء أحياء عند ربهم، فضلًا عن ذلك، إن جهادهم في الدنيا سيحفظه الله سبحانه ويراكم عليه لتحقيق فرج الانتصار، ولو عبر الأجيال. وأنه كرّمهم بإكرامين استثنائيين: أولهما: لا يغادرون الدنيا إلا وقد عرفهم مكانهم عند ربهم، وثانيهما: مصيرهم الجنة والرضوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة محمد، الآية 1.
[2] سورة محمد، الآيات 1- 3.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
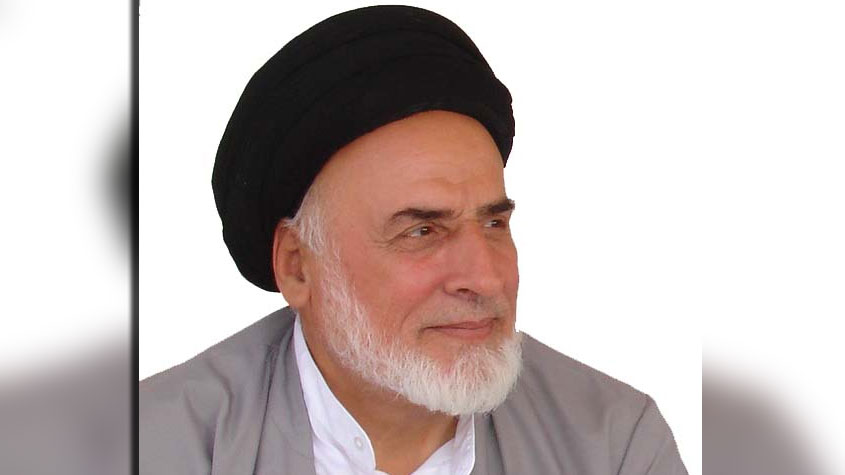 كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!
كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!
السيد جعفر مرتضى
-
 العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا
العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا
السيد عباس نور الدين
-
 حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)
حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)
محمود حيدر
-
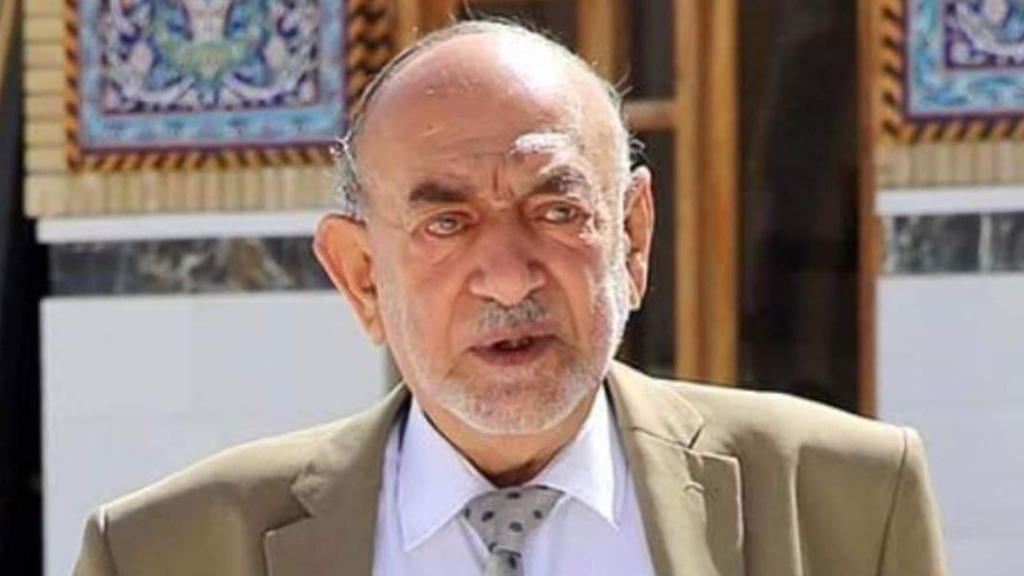 شكل القرآن الكريم (4)
شكل القرآن الكريم (4)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة
الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 الإيمان والطّمأنينة
الإيمان والطّمأنينة
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله
الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
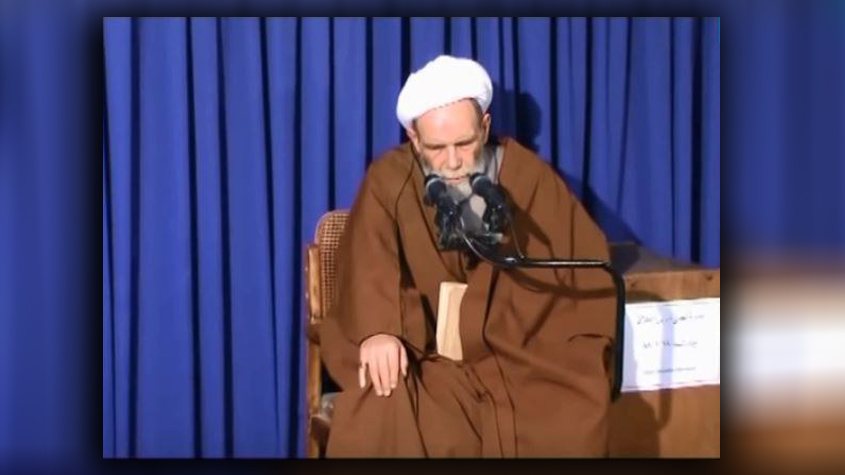 طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا
طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا
الشيخ مجتبى الطهراني
-
 الهداية والإضلال
الهداية والإضلال
الشيخ شفيق جرادي
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
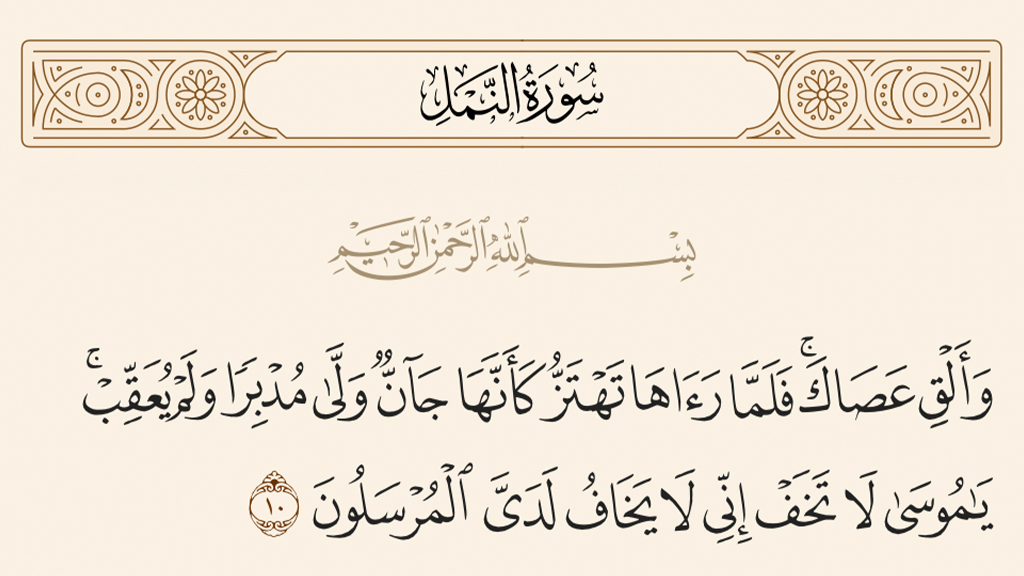
كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!
-

كم ساعة يجب أن تنام وفقًا لعمرك؟
-

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا
-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)
-
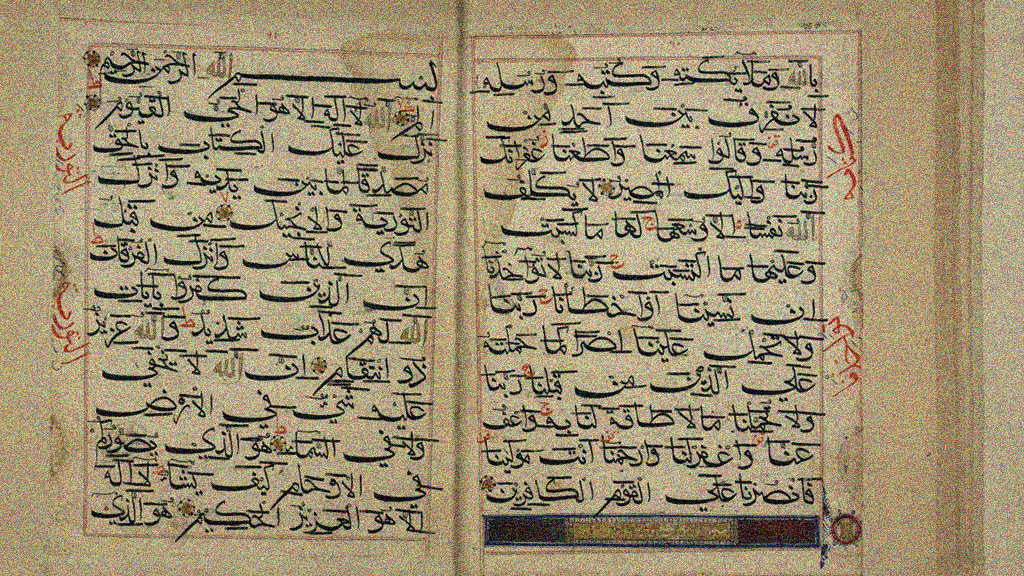
شكل القرآن الكريم (4)
-
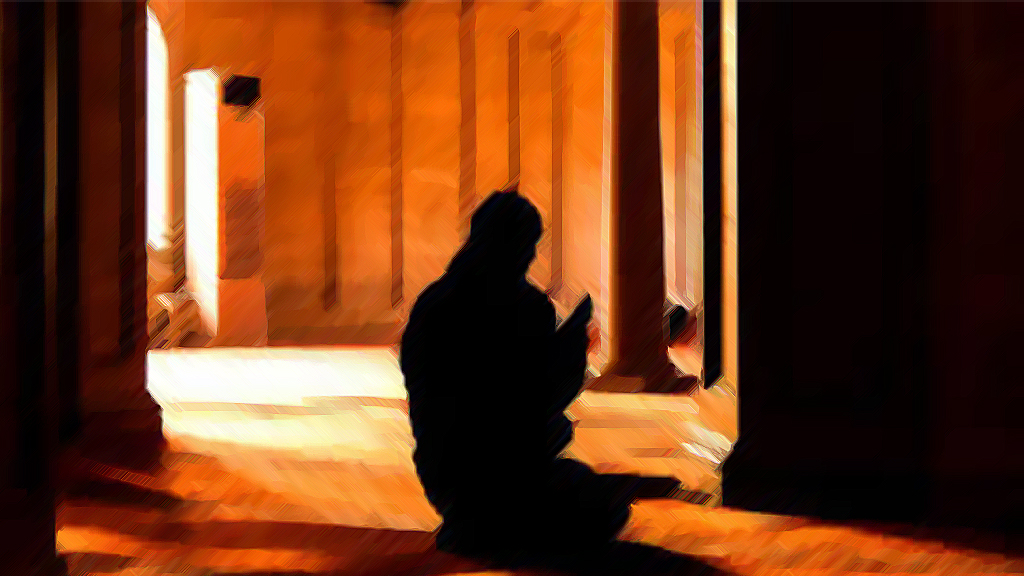
الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة
-
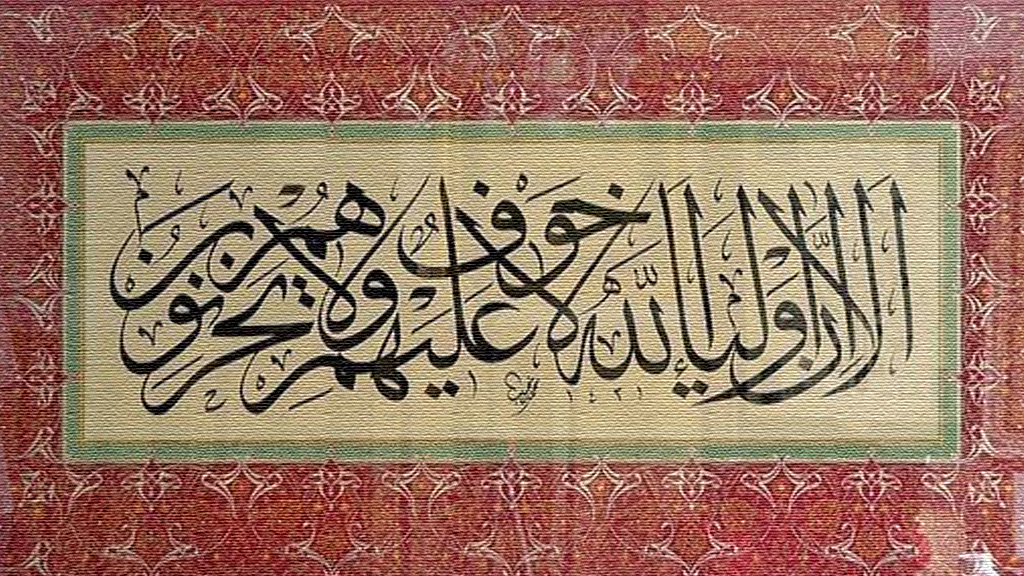
الإيمان والطّمأنينة
-
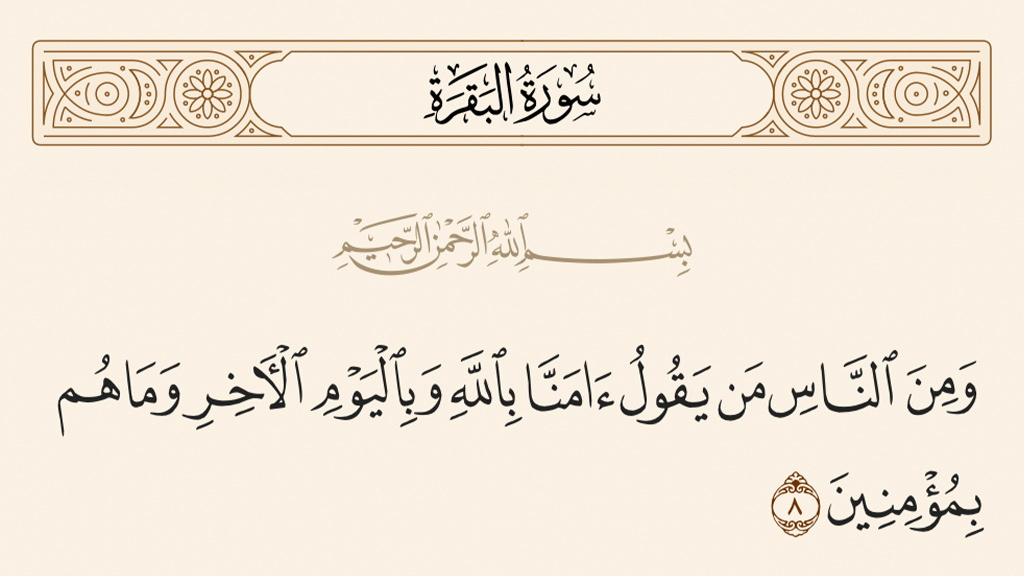
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}
-
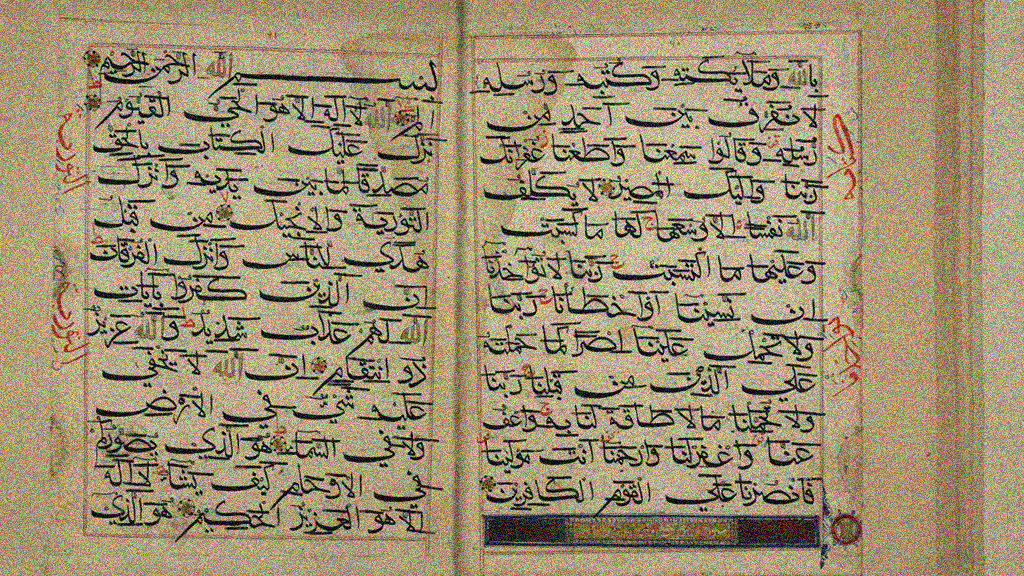
شكل القرآن الكريم (3)
-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)