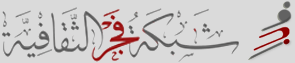علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (2)

في إشكال الجمع بين الحكمتين
مرّ معنا أن المنهج المُعتمد في الفلسفة هو (المنهج البرهانيّ)، وهو قِوَام الفلسفة وشرطها الجوهري؛ باعتبار أنّ الفلسفة هي علم معرفة الوجود عقلاً لا مُطلق معرفة الوجود. ويترتّب على ذلك، أن معيار كون القضيّة الصادقة فلسفية، لا يرجع إلى ملاحظة مضمونها المُرتبط بمعرفة الوجود فقط، بل يرجع أيضاً إلى المنهج المُعتمد في تحديد صدقها. ولذا لا يمكن النظر إلى القضيّة الصادقة التي تتضمن قانوناً وجودياً بوصفها قضية فلسفية إلاّ إذا كان طريق إثبات صدقها هو طريق البرهان. وبناء على هذا لا يصحّ لنا اعتبار القضيّة الوحيانيّة، أو التي يتم التوصّل إليها عن طريق الكشف العرفاني، بديلاً للاستدلال الفلسفي، أو بديلاً لمقدّمة من مقدّمات ذلك، ولو كان صدْقُ مثل هذه القضيّة أكثر يقيناً من صحّة الاستدلال المذكور أو صدق مقدماته[1].
هذه المقدمة تفتح الطريق على إجراءات مصالحة ضمن حقول مزمنة من الخلاف. وهو ما سعت الحكمة المتعالية إليه على الرغم من ديمومة الجدل في هذا الشأن. ففي حقل الإشكال بين الحكمة القرآنية والفلسفة، كان يطرح السؤال التالي:
هل منهج الحكمة المُتعالية هو كسائر النُّظُم الفلسفة الإسلامية يعتمد على البرهان؟ الجواب كما تقدمه الحكمة المتعالية هو أن البرهان لا يقتصر أمره على كونه طريقاً يُطمأنّ إليه للوصول إلى أحكام صادقة، وطريقاً مرضياً للوصول إلى الحق والحقيقة:
“البرهان طريقٌ موثوقٌ به، موصِلٌ إلى الوقوف على الحقّ”[2]. و”العقل أصلُ النقل، فالقدحُ في العقل، لأجل تصحيح النقل، يقتضي القدح في العقل والنقل معاً”[3].
كما لا يُمكن بموجب هذا الشرط أن نجعل من حاصل الكشف العرفاني – دون أن يكون مُلهَماً من الاستدلال العقليّ الموافق له – مُستنداً للأحكام الفلسفيّة، بل إنّ الكشف الصحيح والتامّ في الأمور العقلية الخالصة لا يتيسّر إلاّ عن طريق الحدس والبرهان. ونعني بالحدس هو الذي يكون نتاجاً للرياضات العقلية والشرعية ونتيجةً للمجاهدات العلميّة والعمليّة.
سؤال آخر يلقى على الإشكال إيّاه:
هل يُمكن لملاّ صدرا الالتزام بهذا الشرط (الحدس والبرهان)، في مقام العمل، مع ما في كُتبه الفلسفية والحِكَميّة من وفرة في الآيات والروايات وكلمات العرفاء والأئمة والمُعطيات الشهودية؟
كان ملا صدرا نفسه يقول بشغف: “تباً لفلسفةٍ لا تكون قوانينها مطابقة للكتاب والسنّة”[4]. إلاّ أنه من وجه آخر لم يكن يرى من صحة في إطلاق صفة الحكمة على الفلسفة التي لا تكون مؤيَّدة بالكشف، كما لا يُطلق تسمية الحكيم على الفيلسوف الذي لم يصل إلى هذا المقام ذلك أن “حقيقة الحكمة عند ملا صدرا إنما تُنال من العلم اللدنيّ، وما لم تبلغ النفس هذه المرتبة فلن تكون حكيمة”[5].
هل يستلزم هذا الأمر أن نعتبر أن الحكمة المُتعالية في الوقت الذي ترى صحّة الاستناد إلى الوحي والكشف، لا ترى أن يكون المنهجُ البرهانيّ هو شرط الفلسفة وقِوامَها؟ الجواب هو النفي ذلك لأن طريق الاستفادة من هذا النوع من القضايا في الحكمة المُتعالية يتمُّ بنحو لا يتنافى مع الشرط المذكور، ولا يشكّل نقضاً له. وذلك لأن الشرط المذكور لا يجعل الاستفادة من الوحي والكشف في الفلسفة ضمن دائرة الممنوع مطلقاً، بل يمنع من ذلك في دائرة محدّدة. وهي أن تكون حَكَماً يتمُّ من خلالها تحديد صدق القضايا وكذِبِها. فبناءً على هذا الشرط لا يصحُّ جعل الوحي والكشف بديلاً عن البرهان أو مقدمة من مقدماته، كما لا يصح جعل ذلك منهجاً في تعيين صدق القضايا الفلسفية، أو بديلاً في النقض العقلي. من هنا يظهر أن الاستفادة من أقوال الأكابر في الحكمة المُتعالية، وفي أيّ نظامٍ فلسفيّ، إذا كان في غير مقام الحُكم، لا تشكل نقضاً لهذا الشرط، وهو لا مانع منه[6].
من برهان الأرض إلى برهان السماء:
لم يكن من باب يطرقه صدر المتألهين يستدل منه على حقيقة الوجود، سوى إمعان النظر في المنطقة المعرفية الوسطى. فقد راح يتدبر الكلام الإلهي والسنَّة النبوية، والمأثور من روايات أهل البيت، ليتوصل إلى برهان يقوم على إثبات وجود الخالق من دون توسطات المخلوق. وهذا ما انشهر قبله ومعه بما سمي «برهان الصدِّيقين». وهو الطريق البرهاني الذي كان أخذ به كل من الفارابي وإبن سينا من دون أن يؤصّلاه أو يتوسَّعا به كما فعل صدر المتألهين، إذ جعله ركناً تأسيسياً في مشروعه الفلسفي. و«الصدِّيقون» على ما اتفق عليهم هم أولئك النفر القلائل الذي اعتقدوا أنهم عندما يتأملون الواقع يرون الحق المتعالي قبل أي شيء آخر. ليس فقط أن هؤلاء يدركون أو يعلمون الحق تعالى بالتصور والنظر، وإنما يشهدون وجوده.. ومعادلة نظر الصدِّيقين هي بالترجيح بين العلم المتحصِّل بالتأمل الرياضي المجرد، والشهود المتحصِّل بالكشف والمعاينة. ولأنهم يرجِّحون الثاني ويأخذون بناصية الكشف والشهود، سيكون لهم بالآيات البيّنات مبتدأ السفر الأول باتجاه التصديق. حيث جعل تعالى في كتابه مقام الصديقين بعد مقام النبوة في قوله:(وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا)[7]…
وعلى منشأ الآيات يمضي «الصدِّيقون» إلى الأخذ بالعلوم الكشفية للأنبياء والأوصياء والأئمة. وثمة الكثير مما ورد في هذا المجال: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» وفي الدعاء «يا من دلّ على ذاته بذاته» أو ما جاء عن الإمام علي في النهج: توحيده تمييزه عن خلقه. وحكم التمييز بينونة صفة، لا بينونة عزلة «أو «بك عرفتك وأنت دللتني عليك» أو «ما رأيتُ شيئاً إلاّ ورأيتُ الله قبله وبعده وفيه»[8].
في حيز العقلي فإن برهان الصدِّيقين ينطلق من حقيقة أن وجود الله بديهي، والبديهي لا يحتاج إلى دليل عليه، وأن قضية أن (الله موجود) هي قضية أولية.
لم يبلغ صدر المتألهين ما بلغه في حقل العثور على سبيل برهاني مخصوص لاستكمال بيان الحكمة المتعالية إلاّ بعد اختبارات مضنية أجراها مع أهل الاستدلال والكلام والصوفية وأرباب الكشف. من هنا جاءت طريقة ملاّ صدرا متميزة من سائر الطرق. فهي جمعت بين مسلك الكشف والشهود وطريقة الرأي والفكر. ولهذا جاء كتابه «الحكمة المُتعالية» مشتملاً على أكمل البراهين النظرية وأندر القواعد الكشفية، وكان كمال المطلوب لديه – كما يبيّن في مقدمة الشواهد الربوبية – هو إكمال هاتين الناحيتين. ذلك أن نهاية تكميل القوة النظرية وغايتها، تكمن في تصوير النفس الناطقة بصورة الوجود ونظام عالم الوجود، وبالتالي «صيرورتها عالماً عقلياً» مضاهياً للعالم العيني ومشابهاً «لنظام الوجود». وحقيقة الأمر أن تصور نظام الوجود على ما هو عليه يجعل من النفس مادة ومحلاً لصور الأشياء، ومعدناً لتصوير جميع الحقائق. لا بل تصبح النفس الإنسانية – حسب الحكمة المتعالية - متحدة بحقائق عالم الوجود بناء على اتحاد العاقل والمعقول»[9].
هذا الفن من الحكمة - كما يبيّن صدر المتألهين – هو ما يظهر في دعاء النبي: (رب أَرِنا الأشياء كما هي). وهو ما نجده أيضاً في دعاء النبي إبراهيم (ع) “رب هب لي حكماً”. والحكم المطلوب في الدعاء الإبراهيمي هنا، هو التصديق بوجود الأشياء المستلزم والمطابق لتصورها. وأما (الأخذ بهذه) العملية فثمرتها، مباشرة عمل الخير لتحصيل الهيئة الاستعلائية للنفس على البدن، والهيئة الإنقيادية الانقهارية للبدن حيال النفس. وإلى هذا الفن أشار صاحب الحكمة المتعالية إلى ما جاء في القرآن “ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم“وهي صورته التي هي من طراز عالم الأمر. “ثم رددناه أسفل السافلين” وهي: مادته التي هي من الأجسام المظلمة الكثيفة. “إلاّ الذين آمنوا” وهي الإشارة إلى غاية الحكمة النظرية.. ”وعملوا الصالحات“ إشارة موازية ومتصلة، إلى إتمام الحكمة العملية”[10]. وعند منتهى هذه النقطة تكون النفس الكاملة قد دخلت رحاب الحكمة البالغة لتتلقى منها ما يؤيد القلب ويربط على الفؤاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – عبد الرسول عُبوديت- النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية- الجزء الأول- تعريب علي الموسوي- مراجعة خنجر حمية- مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي- بيروت- 2010- (ص 99)
[2] – الأسفار، ج 5، ص 91.
[3] – أنظر أيضاً: الأسفار، ج3، ص 475؛ ص 108؛ ج5، ص 33؛ وص 296، و91. رسالة في الحدوث، ص 52؛ شرح الهداية الأثيرية، ص 278؛ شرح أصول الكافي، ص 294.
[4] – الأسفار، ج 8، ص 303. أنظر أيضاً: المصدر نفسه، ج 5، ص 205، 206؛ المصدر نفسه، ج 7، ص 326 و327؛ المصدر نفسه، ج 8، ص 303؛ مفاتيح الغيب، ص 143؛ المبدأ والمعاد، ص 4: «رأيت التطابق بين البراهين العقليّة والآراء النقليّة وصادفت التوافق بين القوانين الحِكَميّة والأصول الدينية».
[5] – مفاتيح الغيب، ص 41 أنظر: الأسفار، ج 7، ص 326: «إن مجرّد البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم في السير».
[16] – عبد الرسول عبوديت- مصدر سبق ذكره- (ص 101- 102- 103)
[7] – سورة النساء، الآية 69.
[8] – نهج البلاغة- تصنيف وجيه لبيب بيضون- ص 153
[9] – ملا هادي السبزواري – تعليقات على الشواهد الربوبية – تعليق وتصحيح ومقدمة سيد جلال الدين آشتياني- دار إحياء التراث العربي- ص 15.
[10] – المصدر نفسه- ص – 16
تعليقات الزوار
الكتاب
-
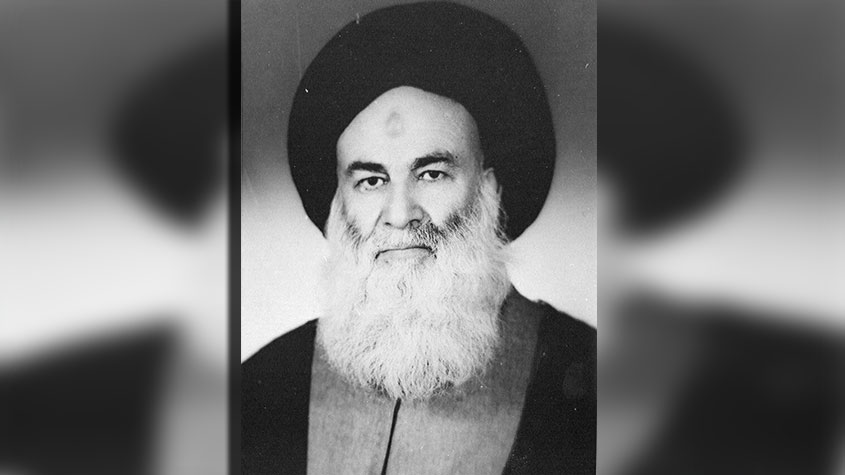 مَن أحبّ شيئًا لهج بذكره
مَن أحبّ شيئًا لهج بذكره
السيد محمد حسين الطهراني
-
 وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (2)
وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (2)
محمود حيدر
-
 الأطفال يبدأون التفكير منطقيًّا أبكر مما كان يعتقد
الأطفال يبدأون التفكير منطقيًّا أبكر مما كان يعتقد
عدنان الحاجي
-
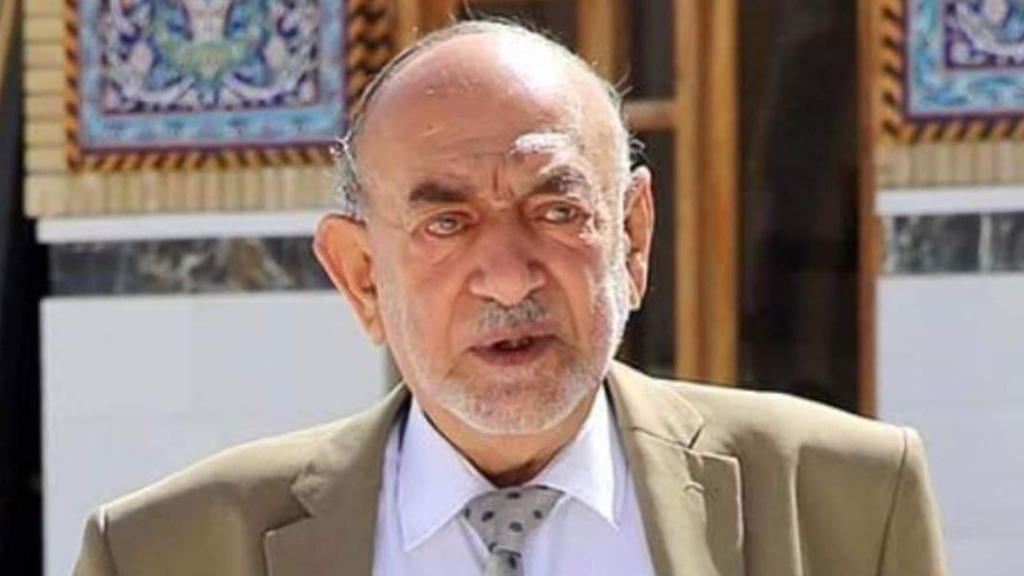 وقوع المجاز في القرآن (2)
وقوع المجاز في القرآن (2)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 سيكولوجية الكفر
سيكولوجية الكفر
الشيخ علي رضا بناهيان
-
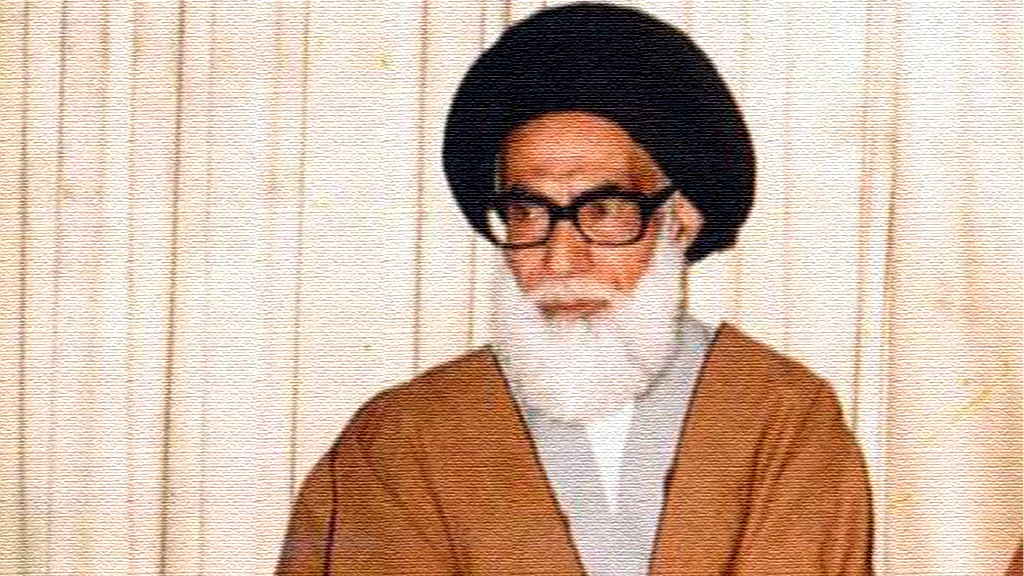 لا تجعل في قلبك غلّاً
لا تجعل في قلبك غلّاً
السيد عبد الحسين دستغيب
-
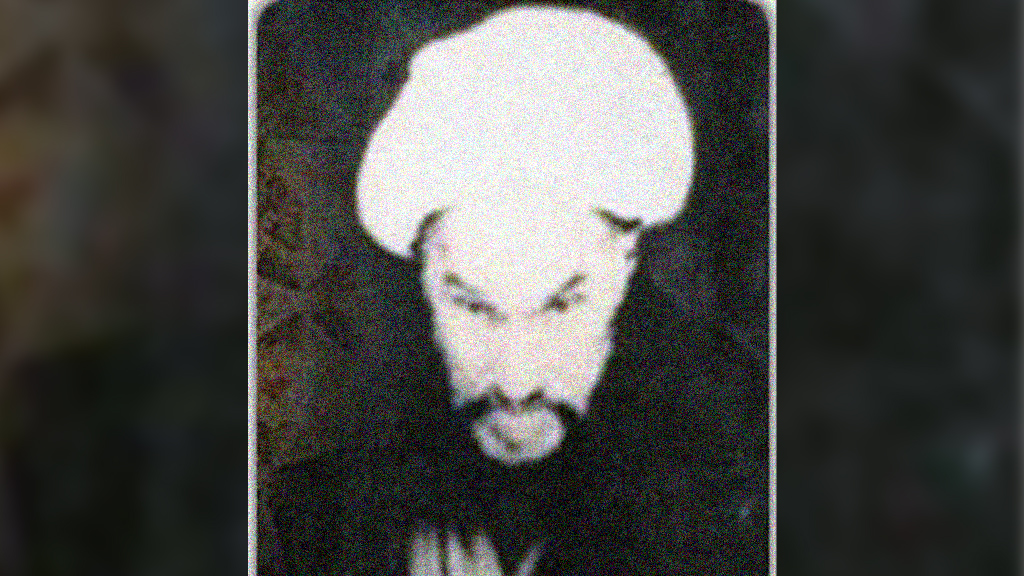 قانون معرفة الفضائل الكلي
قانون معرفة الفضائل الكلي
الشيخ محمد مهدي النراقي
-
 معنى قوله تعالى ﴿لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾
معنى قوله تعالى ﴿لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
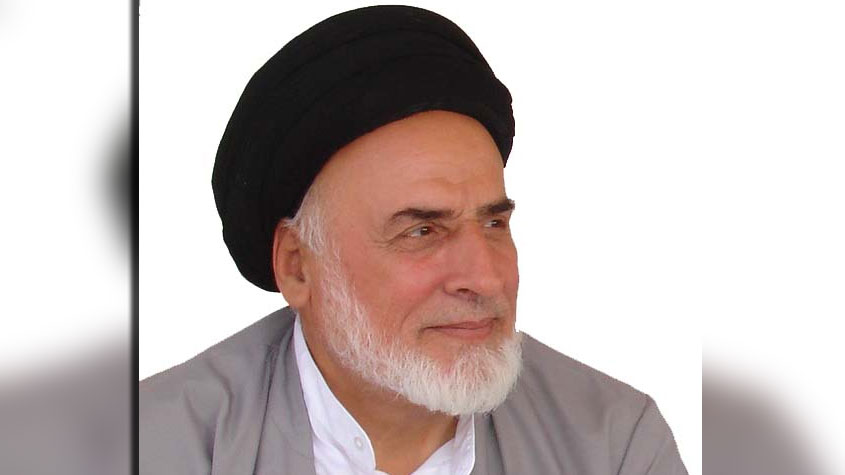 ضرب النقود في الإسلام (3)
ضرب النقود في الإسلام (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 حملة جيش أبرهة على الكعبة المشرفة عبرة لمن يعتبر
حملة جيش أبرهة على الكعبة المشرفة عبرة لمن يعتبر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

مَن أحبّ شيئًا لهج بذكره
-
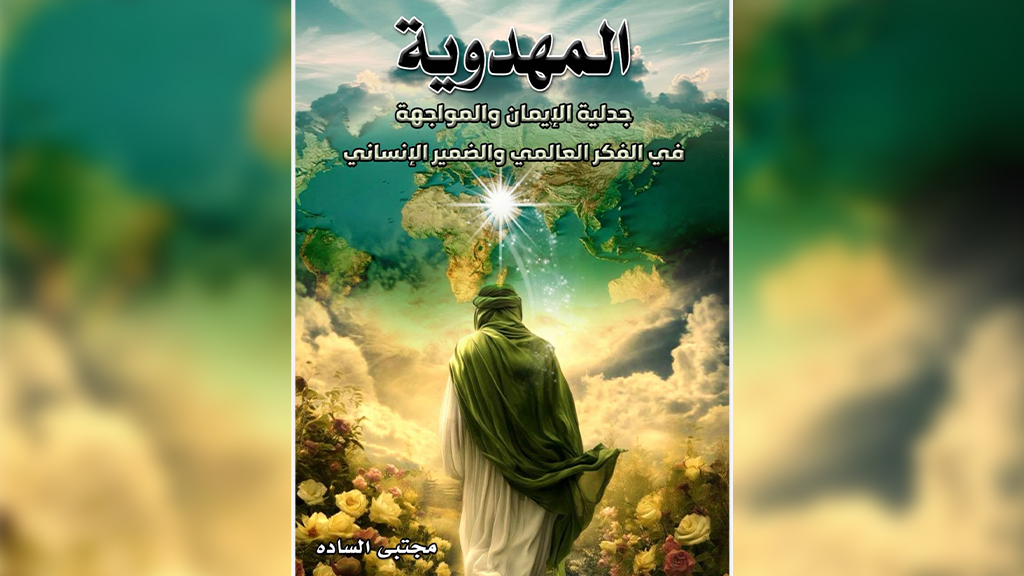
(المهدوية، جدليّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالميّ والضّمير الإنسانيّ) جديد الكاتب مجتبى السادة
-

وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (2)
-

الأطفال يبدأون التفكير منطقيًّا أبكر مما كان يعتقد
-
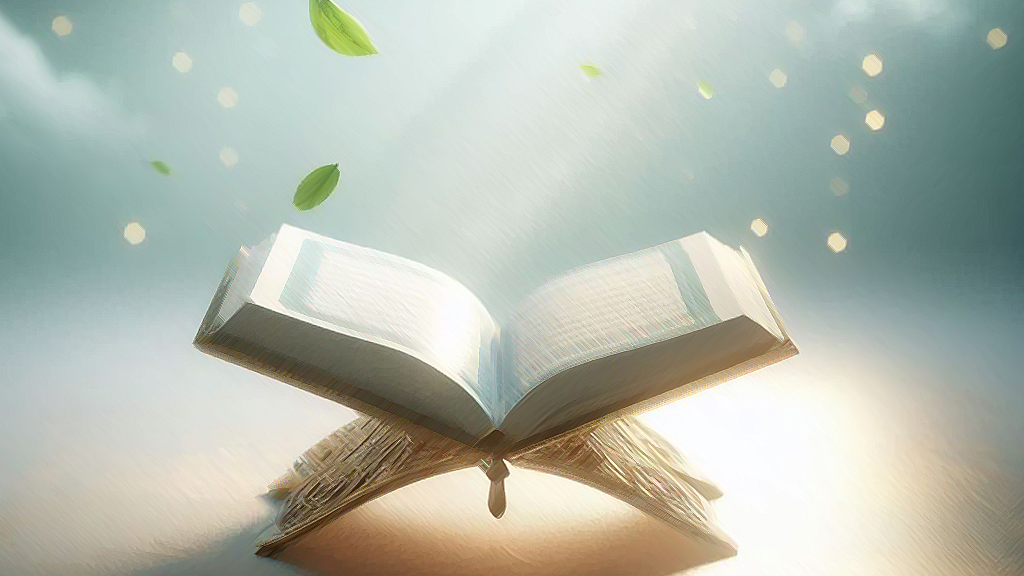
وقوع المجاز في القرآن (2)
-
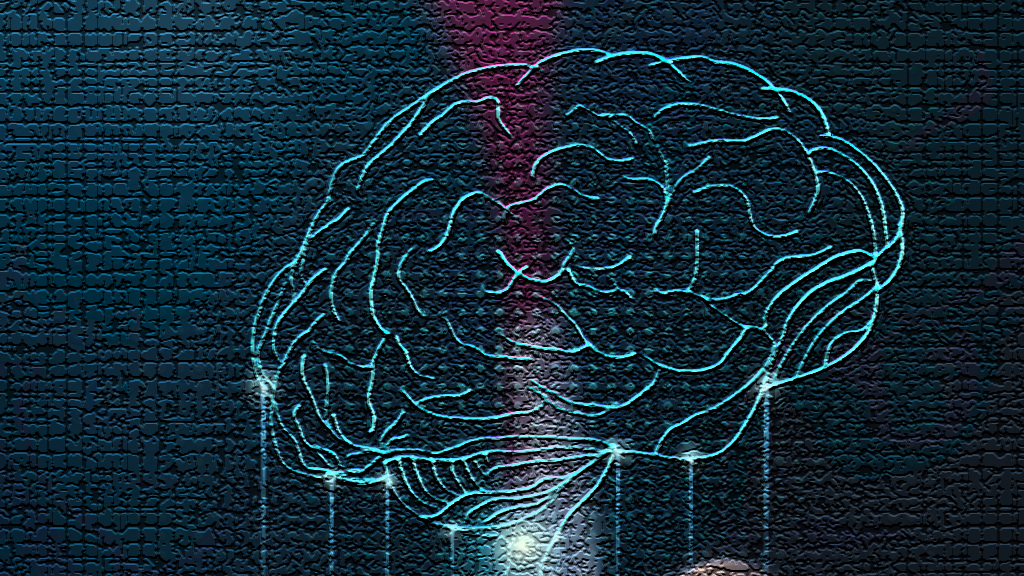
سيكولوجية الكفر
-

المسلّمي يدشّن كتابه الجديد: (آداب المجالس الحسينيّة)
-
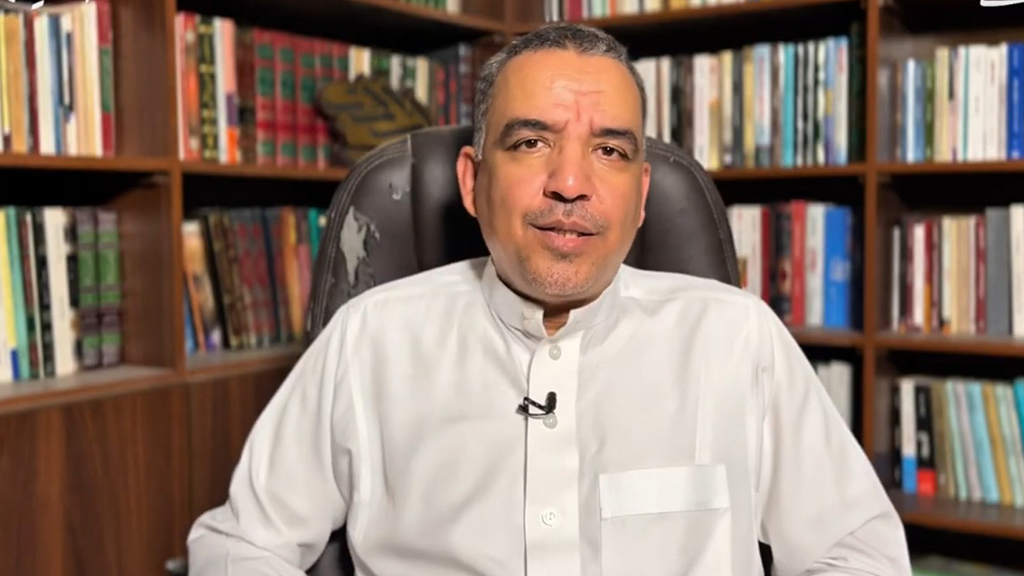
زكي السالم: (معارض الكتاب بين فشخرة الزّائرين ونفخرة المؤلّفين)
-

لا تجعل في قلبك غلّاً
-

قانون معرفة الفضائل الكلي