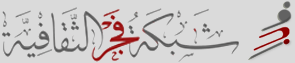علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالتسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (4)
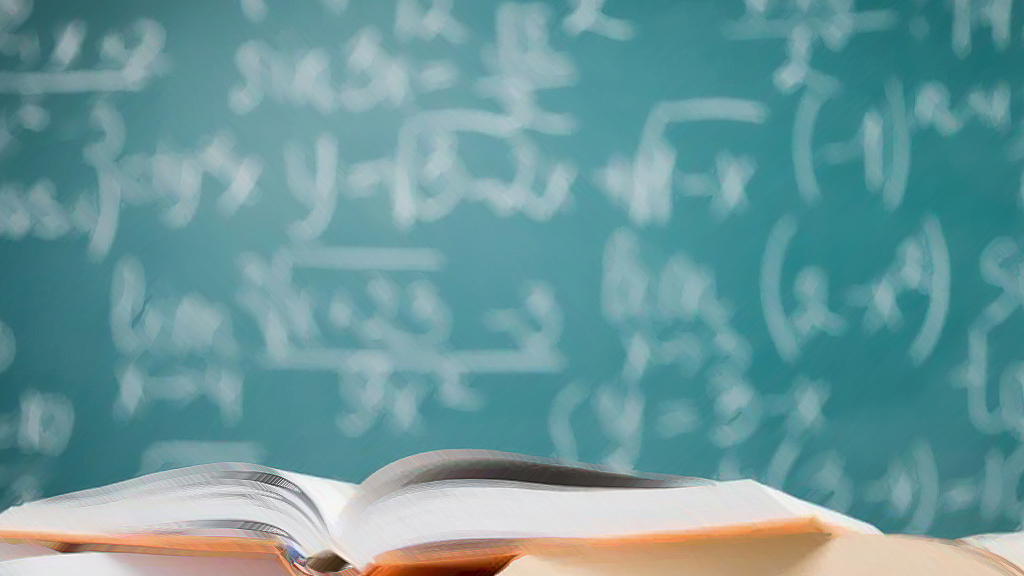
الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله (١٩٣٨ ـ ٢٠٠٨م) عندما استوقفته إشكالية التحيّز عند دراسته للظواهر الإنسانية، اختار المصطلح: “التحيّز”، بالرجوع إلى المعجم اللغوي العربي، وفيه: أن التحيّز يعني الانضمام والموافقة في الرأي وتبنّي رؤية ما، مما يعني رفض الآراء الأخرى. وقد اختار هذا المصطلح ليطلقه على مجال جديد لدراسة ظاهرة إنسانية من صميم المعطى الإنساني، ومرتبطة بإنسانية الإنسان، كما كان يرى، وهي ظاهرة [1] وضع الدكتور المسيري قواعد أساسية تساعد على فهم التحيّز وتمييزه، وهي:
١ ـ القاعدة الأولى: التحيّز حتمي: وذلك بسبب المعطيات التالية:
أ ـ لأنه مرتبط ببنية عقل الإنسان ذاتها، فهذا العقل لا يسجّل تفاصيل الواقع كالآلة الصمّاء، فهو عقل فعّال، يدرك الواقع من خلال نموذج فيستبعد بعض التفاصيل ويبقي بعضها الآخر.
ب ـ التحيّز لصيق باللغة الإنسانية المرتبطة إلى حدّ كبير ببيئتها الحضارية، وأكثر كفاءة في التعبير عنها. فلا توجد لغة تحتوي كل المفردات الممكنة للتعبير عن الواقع بكل مكوّناته، فلا بدّ من الاختيار.
ج ـ التحيّز من صميم المعطى الإنساني، ومرتبط بإنسانية الإنسان، أي بوجوده ككائن غير طبيعي، لا يردّ إلى قوانين الطبيعة العامة ولا ينصاع لها، فكل ما هو إنساني يحوي على قدر من التفرّد والذاتية ومن ثمّ التحيّز.
٢ ـ القاعدة الثانية: التحيّز قد يكون حتمياً ولكنه ليس نهائياً:
فالتحيّز ليس بعيب أو نقيصة، بل على العكس يمكن أن يُجرّد من معانيه السلبية، ويصبح هو حتمية التفرّد والاختيار الإنساني.
واللغة الإنسانية رغم حدودها قادرة على تحقيق التواصل، وعلى مساعدتنا على تجاوز أشكال كثيرة من التحيّز، وعلى بناء نماذج معرفية هي نتاج تجربتنا الحضارية الخاصة، ولكنها بنفس الوقت تساعدنا على التعامل مع أنفسنا ومع واقعنا ومع الآخر. فمعنى أنه ليس نهائياً أي أنه ليس نهاية المطاف حيث يمكن تجاوزه، ولكن النهائي هو الإنسانية المشتركة والقيم الأخلاقية الإنسانية [2].
إلا أن قول المسيري أن التحيز حتميّ يحتاج توضيحًا وفق ما أفهمه للتحيزات الحتمية، كون الحتمي لا يمكن تجاوزه كما قال الدكتور المسيري، وقد يكون المسيري يقصد من الحتمية كونها أمرًا واقعيًّا تكوينيًّا في الإنسان ضمن تركيبته البيولوجية التكوينية كما أشرنا في آية خلق الإنسان من عجل، إلا أنه خلق قابل للتغيير بالمجاهدة والإرادة الحرة وإلا كان جبًرا وخلاف العدل الإلهي، وتجاوزه يأتي من خلال التعلم والتدريب المعرفي البحثي والممارسة البحثية على الطرح الموضوعي وكسب ثقافة الخروج من الصناديق المعرفية المغلقة، دون التنازل عن الثوابت التي تشكل حقائق ثابتة في الهوية المعرفية، فالباحث أو المثقف لابد له من أن يتحيز للحقيقة والحق، لكن ذلك لا يتم إلا بعد أن يستعرض ويستقرئ كل الآراء التي طرحت بخصوص الموضوع محل البحث، أي أن يقوم بعملية ضرب للآراء ببعضها البعض، ومن ثم يخرج بالرأي الأقرب للحق والحقيقة، وينحاز له ليطرحه ويدافع عنه، وهذا الانحياز المعرفي هو انحياز صحيح وصحي في ذات الوقت، إلا أنه مشروط بعدة شروط أهمها:
١. أن يعتمد الباحث والمثقف في فهمه للواقع واستقصائه للمعارف على مصادر المعرفة البشرية المعتمدة من المدرسة التي تنتمي هويته إليها، مضافًا إلى ذلك اطلاعه على المدارس الأخرى في المعرفة.
٢. استقراء جل الآراء وأهمها المطروحة في الموضوع خاصة البحث، واستعراضها عرضًا نقديًّا علميًّا، ومن ثم الخروج وفق منظوره برأي.
٣.المراجعة النقدية لما توصل إليه من رأي، واعتباره عرضة للنقد والتطوير والتراكم المعرفي من قبل الباحثين والمثقفين الآخرين.
٤. التجرد من الأنماط والرغبات الاجتماعية معرفيًّا “الشعبوية”، والتجرد من ثقافة الإجماع السلبية ومبدأ المشهور المعرفي العلمي.
٥. والأهم من كل ما سبق هي معيارية العدالة المرجعية في تشخيص صلاح هذا التحيز المعرفي لأن العدل معيار للحق، والانحياز للحق هو انحياز إيجابيّ، ولكي يحقق هذه المعيارية على المثقف والباحث أن يكون حرًّا في بحثه المعرفي.
وأغلب التحيزات المعرفية تعمد إلى حجب الحقيقة، ومن أهم مسببات التحيزات المعرفية هي:
١. البيئة والمحيط الاجتماعي والأسري، الذي يعمل على تنميط الأفكار والمنهجيات ومصادر المعرفة.
٢. مناهج التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ويتربى عليها الطفل، ومناهج التدريس التي يستخدمها المعلم في تعليم التلاميذ.
٣. الانتماءات العصبوية بكافة أشكالها سواء القبلية أو المذهبية أو الطائفية.
٤. الأنماط الاجتماعية والإجماع السطحي القائم على الشعبوية بمعناها السلبي، فقوة الإجماع الشعبي تخلق تسالـمًا سطحيًّا للمعارف، وبالتالي تصنع جوًّا معرفيًّا متحيزًا بشكل غير منطقي وموجهًا للرأي العام، هذا الإجماع الشعبوي يستخدم فيه قوة خفية تفرض من خلالها هذه الإجماعات رأيها، وهذه القوة الخفية تتعلق بالشعور والرغبة الداخل نفسية بالانتماء للجماعة والخوف من الخروج والمخالفة، إلا أن المثقف والباحث عليه أن يتخلص من هذه المخاوف، وأن لا يخضع لهذه القوة الخفية التي يكتنزها الإجماع الشعبوي، وأن يكون نفسيًّا وشعوريًّا متحررًا من الانتماء للجماعة ليصبح شعوره الأصيل الداخل نفسي هو الانتماء للحق والحقيقة، وفهم الواقع وملابساته لتعرية كل الوهم المرتكز في العقل الجمعي السلبي الأبعاد، وليناضل كمثقف وباحث وظيفته صناعة الوعي، يناضل لأجل استبدال هذا الوهم بالحقيقة.
٥. الثقافة والتربية الأحادية المتوارثة دون مراجعة وتمحيص، تصنع عقلاً أحادي المنهج والفكرة، وتخلق تحيزات معرفية لاغية لكل ما هو خارج هذا الصندوق المعرفي المتوارث، والمورث للاطمئنان التواضعي البسيط.
٦. التحيز المعرفي الناشئ عن أخلاقية الخضوع والانهزام النفسي أمام معارف الدول الأقوى حضاريًّا، والأكثر تقدمًا في الانتاج المادي والمعرفي، أي هو تحيز نتيجة الفارق الحضاري والانبهار، وهو تحيز له بعد نفسي، وله بعد معرفي. وهو من أكثر التحيزات التي يقع في شباكها المثقف والباحث.
ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه المثقف والباحث هو الخروج من التحيزات المعرفية التي تتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، لأن وظيفته صناعة وعي واقعي قائم على أسس معرفية رصينة، وأدوات ومناهج سليمة علميًّا، كون التحيزات تعمل كمضادات حيوية للمعرفة والوعي، وكحُجُب موجهة للمعرفة باتجاهات محددة ومغلقة ونمطية.
لذلك كان لزامًا على المثقف والباحث الذي يتصدى لصناعة الوعي، وتطوير المعارف والعصرنة والمواكبة أن يعتمد على عملية النقد المستمر للذات، والمراجعة المستنيرة للأفكار والمناهج والمحتوى الفكري، وإلى المواكبة لكل التطورات المعرفية على الساحة الثقافية، والإلمام بمستحدثات الإشكاليات والمعارف التي تواجه المجتمعات، خاصة أن العولمة حولت المجتمعات إلى قرية صغيرة، تتناقل فيها المعارف وإشكالياتها بالعدوى المعرفية. وهو ما يستدعي المثقف والباحث للخروج المستمر من الصناديق النمطية، إلى فضاءات المعرفة المختلفة، لأن الوعي في حركة تكامل وكمال مستمر، والعقل في سيرورة وصيرورة معرفية تطورية مستديمة، لا تلغي الثوابت لكنها تحصنها بتطوير المتغيرات وفق الزمان والمكان، هذا فضلاً عن اتصافه بالإنصاف العلمي والمعرفي في اعتماده على مصادر معرفة متعددة.
فهناك مثقفون وباحثون يستبعدون مصادر معرفة بشرية كونها لا تتناسب وأيديولوجيتهم وعقيدتهم، مثل المثقف أو الباحث الذي يستبعد النص والعقل، ويعتمد فقط على الحس والتجربة، أو ذلك الذي ينكر دور الحس والتجربة، ويستبعدهما كمصادر ويعتمد فقط على النص والعقل مع تغليب النص وتهميش العقل وهكذا. لذلك المثقف والباحث عليهما ألا ينحازا إلا للحقيقة والحق التي تتطلبان منهما أن يطلعا على الآراء معتمدَين على كل مصادر المعرفة، التي من خلالها يعرف الإنسان ويتعلم ويفهم.
كلها تساؤلات تخضع لعمليتي التسارع والتباطؤ المعرفي، والذي أعني فيه الزمن والوقت الذي يستغرقه الباحث عن الحقيقة في الوصول إلى الإجابات، والمنهج الذي يسلكه، والتحيزات التي يخضع لها، وما هي تداعيات التسارع والتباطؤ على الفرد والمجتمع، وبالتالي على الأفكار المعرفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأمامنا اليوم تجارب غنية بالتسارع والتباطؤ بين الشرق والغرب، فالعلموية أقصت الدين كليًّا وتبنت العلم كمصدر للحقيقة وهو نموذج للتسارع الذي تراكمت عليه مواقف ومعارف لا تسلم من ثغرات حقيقية تم كشفها مع التقادم، وبعض المنتمين للمؤسسات الدينية لم تعتبر العلم مصدرًا مهمًّا وملهمًا ولم تضعه في موقعه المعرفي السليم، وبنت منظومتها المعرفية على هذا التسارع، وواجهت تحديات معرفية كبيرة كان لبعضها الأثر في تهاوي موقع الكنيسة وتراجع موقع الدين ووظيفته من حياة مجتمعات بأكملها.
لذلك نحتاج إلى تشخيص سليم للتسارع والتباطؤ، متى نتسارع ومتى نتباطئ؟ ومتى يكون التسارع مذمومًا والتباطؤ محمودًا ومتى يكون العكس؟ ومتى يكون التنافس يحتاج إلى تسارع ومتى يحتاج إلى تنافس لكن ببطء؟
كلها تساؤلات تتطلب تشخيصًا سليمًا للزمان والمكان وقراءة منهجية لإشكاليات العصر، لفهم الواقع ومواجهته مواجهة معرفية متخلصة من التحيزات المعرفية السلبية، وهمها فهم الحقيقة كما هي وفق أدلة وبراهين قطعية، تستمد من الثوابت قاعدتها التي تنطلق منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مفهوم التحيز عند الدكتور عبد الوهاب المسيري/رغداء محمد أديب زيدان/ تم الاطلاع في ٢٤ـ مايوـ٢٠١٩/ http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=16515
[2] المصدر السابق
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 التسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (4)
التسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (4)
إيمان شمس الدين
-
 من بحوث الإمام الرّضا (ع) العقائديّة (2)
من بحوث الإمام الرّضا (ع) العقائديّة (2)
الشيخ باقر القرشي
-
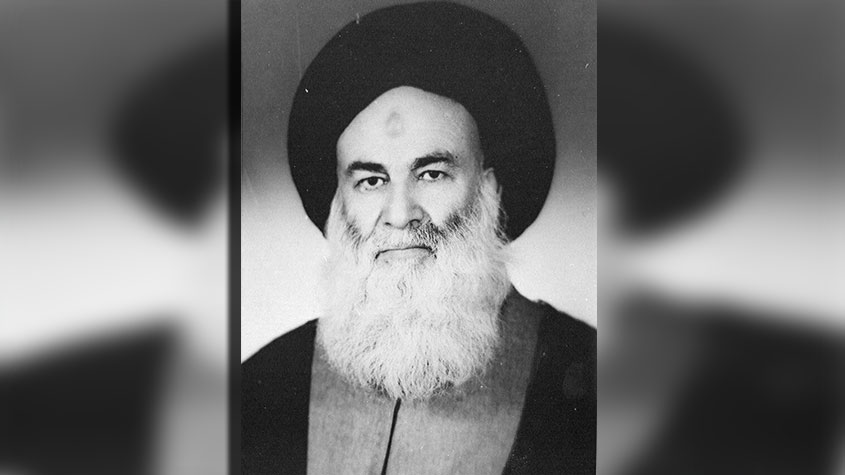 العلّة من وراء خلق الشّيطان والشّرّ
العلّة من وراء خلق الشّيطان والشّرّ
السيد محمد حسين الطهراني
-
 السّكينة والحياة السّعيدة
السّكينة والحياة السّعيدة
الشيخ حسين الخشن
-
 أزمة الحبّ والإيمان (2)
أزمة الحبّ والإيمان (2)
حيدر حب الله
-
 من مؤشّرات الوهن العام
من مؤشّرات الوهن العام
عدنان الحاجي
-
 حقيقة مهمّة: إنّ الإمام الرّضا (ع) يحبّك، يعرفك، وهو يدعو لك!
حقيقة مهمّة: إنّ الإمام الرّضا (ع) يحبّك، يعرفك، وهو يدعو لك!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 نحن والغرب، بحثًا عن روح التقدم والتفوق
نحن والغرب، بحثًا عن روح التقدم والتفوق
السيد عباس نور الدين
-
 كلمة موجزة حول الجمال
كلمة موجزة حول الجمال
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 سعة الصدر
سعة الصدر
الشيخ محمد مهدي الآصفي
الشعراء
-
 شيء من الحنين الرّضويّ
شيء من الحنين الرّضويّ
حبيب المعاتيق
-
 الإمام الرّضا: كعبة آمال المشتاقين
الإمام الرّضا: كعبة آمال المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 هم ليس هم
هم ليس هم
شفيق معتوق العبادي
-
 وعلى هواك
وعلى هواك
جاسم بن محمد بن عساكر
-
 يا إمام اليقين
يا إمام اليقين
عبدالله طاهر المعيبد
-
 عين غزة
عين غزة
رائد أنيس الجشي
-
 عقد يحاول أن يضيء
عقد يحاول أن يضيء
ناجي حرابة
-
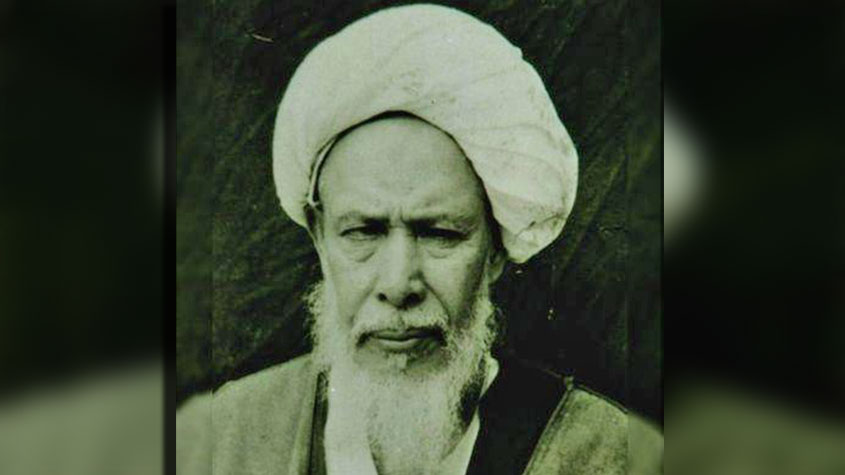 حمزة المفضال
حمزة المفضال
الشيخ علي الجشي
-
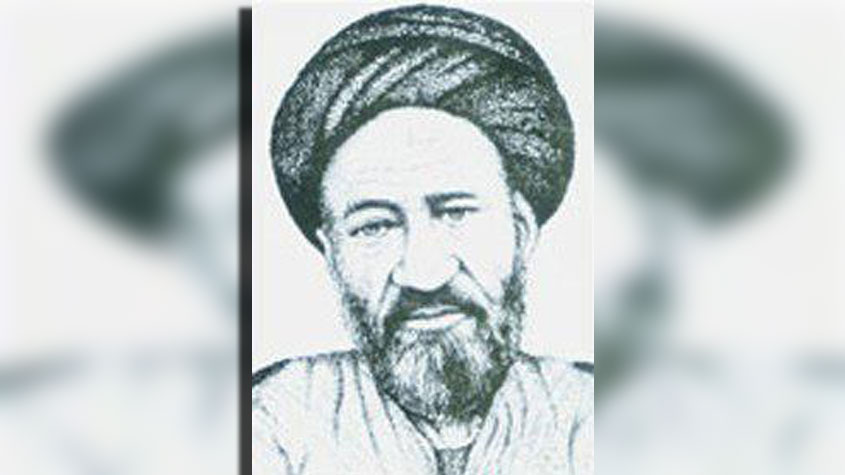 أَعَزَّ اصطباري وأجرى دموعي
أَعَزَّ اصطباري وأجرى دموعي
السيد رضا الهندي
-
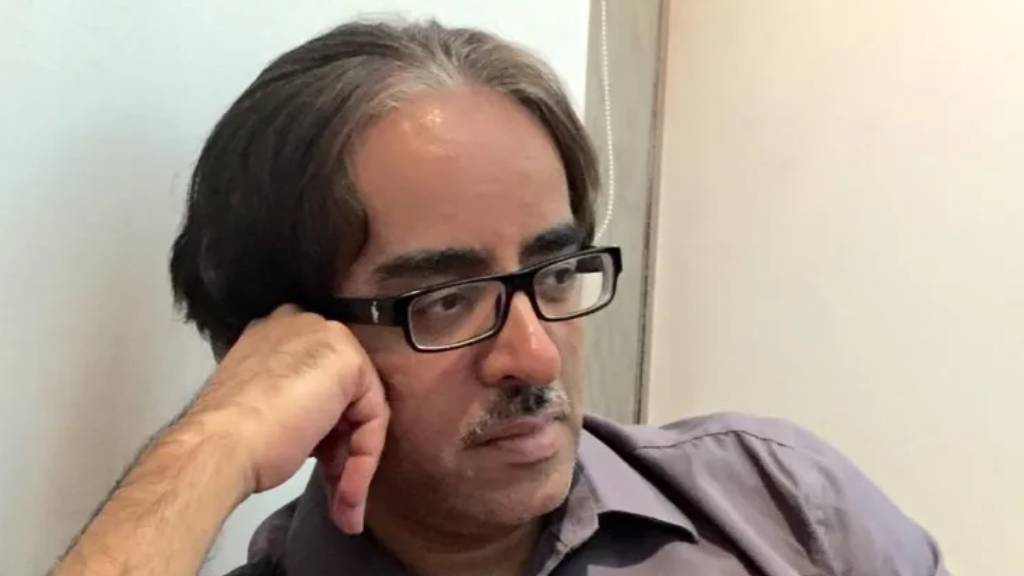 والتّين والزيتون
والتّين والزيتون
عبد الوهّاب أبو زيد
آخر المواضيع
-

الشّيخ صالح آل إبراهيم: كيف تنقذ زواجك من الانهيار؟
-
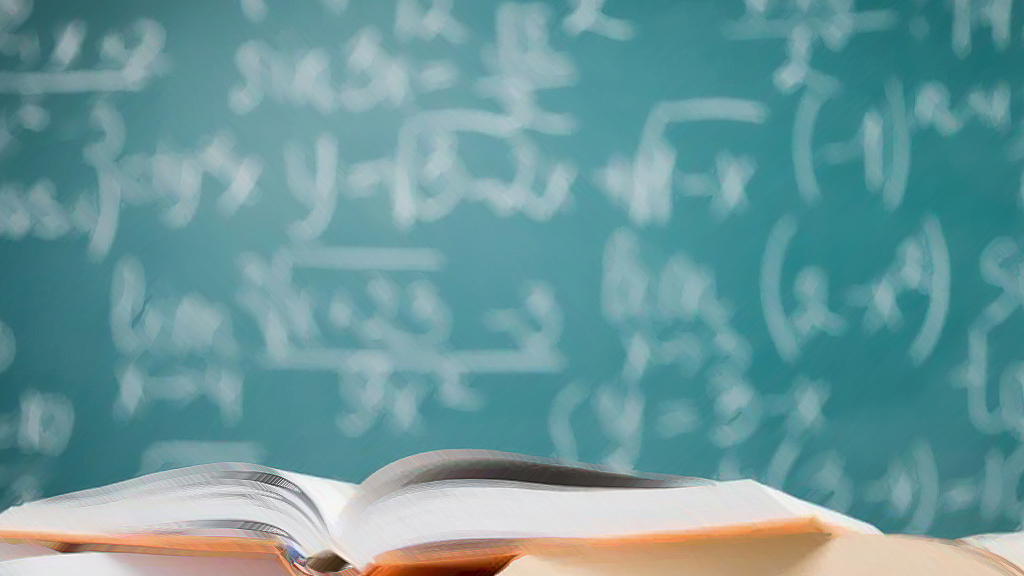
التسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (4)
-

تحمّل المسؤوليّة، عنوان الحلقة الثّالثة من برنامج (قصّة اليوم)
-

ناصر الرّاشد: كيف يستمرّ الحبّ؟
-

من بحوث الإمام الرّضا (ع) العقائديّة (2)
-

الإمام الرضا (ع) والمواقف من النظام (2)
-

شيء من الحنين الرّضويّ
-

الإمام الرّضا: كعبة آمال المشتاقين
-
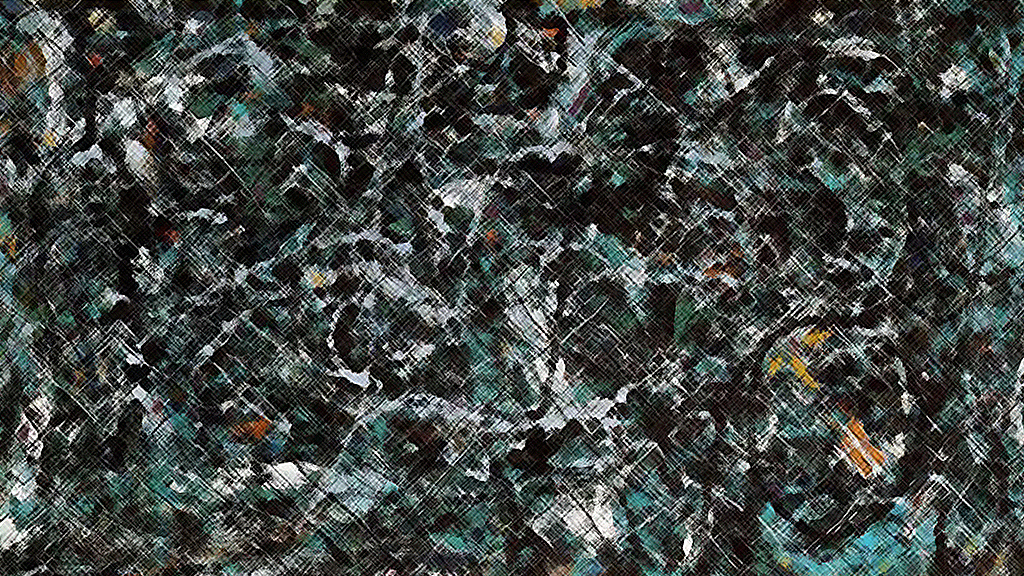
العلّة من وراء خلق الشّيطان والشّرّ
-

السّكينة والحياة السّعيدة