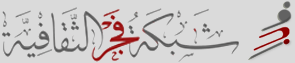علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا السؤال المؤسِّس (2)

المثنَّى كحاضن للسؤال والجواب
كلُّ جملة تجد تتمَّتِها واستمرارها في أخرى. إلَّا أنَّ السؤال لا يجد تتمَّته واستمراره في الجواب. إنَّه، على العكس من ذلك، ينتهي وينغلق بفضل الجواب. ليقيم السؤال نوعًا من العلاقة التي تتميَّز بالانفتاح والحركة الحرَّة. وما يحدِّده ردًّا واستجابة هو بالضبط ما يوقف مدَّ الحركة ويسدُّ أمامها الأبواب. يتلهَّف السؤال إلى الجواب وينتظره، لكنَّ الجواب لا يهدِّئ من روع السؤال. وحتى إن هو قضى عليه وأوقفه فإنَّه لا يقضي على الانتظار الذي هو سؤال السؤال. السؤال والجواب، بين هذين الطرفين مواجهة وعلاقة غريبة، من حيث إنَّ السؤال يتوخَّى من الجواب ما هو غريب عنه، كما يريد في الوقت نفسه أن يظلَّ قائمًا في الجواب كحركة يريد الجواب إيقافها ليخلد إلى الراحة. غير أنَّ على الجواب، عندما يجيب، أن يستعيد ماهيَّة السؤال التي لا يذيبها ما يجيب عنه.
السؤال بما هو سؤال لا محمول له من دون موضوع يحمله. فلا وجود له في الخارج بلا موضوعه. فعندما نطرح سؤالًا عن شيء ما لا يكون هذا السؤال مستقلًّا عن ذلك الشيء. وهنا تكمن خصوصيَّته كمفهوم لا نظير له بين المفاهيم.
أمَّا السؤال فلا يقوم على النفي، لأنَّه ليس نقيض الجواب بل ثمَّة تقابل الوقت والانتظار. وإنَّما سيرورة تناظر تضمُّ طرفيها وتوحِّد بينهما. السؤال والجواب من جنس واحد. والتقابل بينهما لا ينبني على التناقض وإنما على ضدِّيَّة خلّاقة تؤول إلى التكامل والانسجام والوحدة. ولذا فإنَّ فعاليَّة السؤال أشبه بإجراء تلقيحيٍّ لوضعيَّة طبيعيَّة أو فوق طبيعيَّة تتمتَّع بالاستعداد للولادة والانبثاق.
المثنَّى واحد وإن تركَّب من صورتين. ذلك بأنَّ كلًّا من هاتين الصورتين المؤلِّفتين للمثنَّى هي صفة من صفات واحديَّته. لذلك يكون السؤال وجوابه جوهر واحديَّة المثنَّى. ومزيَّة السؤال بوصف كونه مثنَّى أنَّه جوهر يحمل صفتين متلازمتين: الاستفهام والإجابة. وهاتان الصفتان موقعهما واحد في الزمان المطلق. متكثِّرٌ في الزمان الجزئيّ.
فقد يتميَّز شيئان متباينان أحدهما عن الآخر، إمَّا بتنوُّع صفات هذه الجواهر، أو بتنوُّع أعراض هذه الجواهر، فلو وجدت جواهر عدَّة متميّزة بعضها عن بعض لكان تميُّزها إمَّا بتنوُّع الصفات أو بتنوُّع الأعراض. وإذا كان تميُّزها بتنوُّع الصفات فحسب، فإنَّنا سنسلِّم إذًا بأنَّه لا يوجد غير جوهر واحد للصفة الواحدة. وإذا كان تميُّزهما بتنوُّع الأعراض، وبما أنَّ الجوهر متقدِّم بالطبع على أعراضه، فإنَّنا لا نستطيع، -إن نحن أبعدنا الأعراض واعتبرنا الجوهر في ذاته، أي من منظور الحقيقة – أن نتصوَّره متميّزًا عن جوهر آخر. بمعنى أنَّه لا يمكن أن يوجد في الطبيعة جوهران لهما صفة واحدة، أي أنَّهما يتَّفقان في شيء ما. وتبعًا لذلك فإنَّه لا يمكن لأحدهما أن يكون علَّة للآخر، بمعنى أنَّه لا يمكن لأحدهما أن ينتج من الآخر. وما يبرهن على هذه القضيَّة أنَّه لو أمكن للجوهر أن ينتج من شيء آخر لكانت معرفته متوقِّفة على معرفة علَّته، وبالتالي لما كان الجوهر جوهرًا.[1]
وعليه، لا يعمل السؤال وجوابه خارج المثنَّى.. ولا يرتضي لنفسه أن يكون انشقاق الواحد عن الإثنين، بحيث لو تآلف هذان الإثنان من بعد المكابدة في مشقَّة التناقض، أن يظهر كثالث يروح يستعيد استبداد الأنا بالغير ليصبح أولًا من جديد.
بهذه الصيرورة لا يُشتقُّ السؤال من نقيضين: الأنا السائلة والآخر المجيب. بل السؤال بوصفه إرادة استفهام هو ممَّا يُشتقُّ منه، لا من سواه، نظرًا لأصالته وفعاليَّاته التوليديَّة، يستطيع صاحب السؤال أن يتمثَّل حال سواه ويكونه، بشرط أن يعقد النيَّة على الخروج من كهف الثنائيَّة واحترابها. ففي هذا الكهف تحتدم الأنا مع كلِّ من يغايرها هويَّتها. وفي هذه الحال يستحيل كلٌّ منهما نقيضين متنافرين لا يلتقيان على كلمة سواء. بل قد يسعى كلٌّ منهما إلى تدمير نظيره، أو-في أحسن حال- ليقيم معه توازن هلع لا يلبث بعد هنيهة أن ينفجر لتصيب شظاياه الإثنين معًا. ولنا هنا على سبيل المناسبة أن نذكر شاهدًا من مختبرات الحداثة الغربيَّة:
كان نيتشه – وهو ينقد ثنائيَّة الخير والشرِّ في عقل الغرب- يتساءل عن الكيفيَّة التي يمكن لشيء ما أن يولد من نقيضه: الحقيقة من الضلال، إرادة الحقيقة من إرادة الخداع، الفعل الغيريّ من المصلحة الذاتيَّة. ونظر الحكيم النيّر الخالص من الشهوة… وإنّ تولُّدًا من هذا النوع ممتنع –كما يقول نيتشه-.. إذ يجب أن يكون للأشياء ذات القيمة الأسمى منبع آخر وخاصّ. وهذه القيمة لا يمكن أن تُشتقَّ من هذه الدنيا الفانية الغاوية المخادعة الوضيعة، أو من هذا الهرج والمرج من الأوهام والأهواء. إنَّ منبع هذه القيمة الأسمى يجب أن يكون هنالك في حضن الكون، في الَّلافاني في الإله المخفيِّ، في الشيء في ذاته، هناك، وليس في محل آخر”[2].
ولكن، من أين للعالم بسؤال ينقله من جحيم النفي والإقصاء إلى فردوس الفضيلة والاستقبال والرحمانيَّة؟
يمكن القول أنَّ نيتشه أكثر فلاسفة الحداثة ممَّن أسّسوا لسؤال ينفذ إلى الحدود القصوى لاستكناه حقائق العالم الخفيَّة. لقد رأى أنَّ إيمان الميتافيزيقيين الأصليَّ وفي كلِّ الأزمنة، هو الإيمان بأضداد القِيم. ثمَّ ليبيّن “أنَّ علينا أن نترقّب جنسًا جديدًا من الفلاسفة، من الذين لهم ذوق ما، وميلٌ ما، مغاير ومعاكس لأسلافهم.. ولنقل بكلِّ جدّ – كما يقول- : إنّي أرى بزوغ مثل هؤلاء الفلاسفة الجدد[3]“.
هذا الميل المعاكس الذي يريده نيتشه من نبوءته التي مرَّت معنا، هي بالضبط ما يقصده بـ”الإنسان الخلَّاق للفهم” الذي وجده في حكمة زرادشت. فسنرى مثلًا، أنَّ الواجب الأول في تأويليَّته يعني الانتصار على الذات. لذا كان يردِّد على الدوام أنَّ الإنسانيَّة التي يطمح كلُّ إنسان إلى تجاوزها هي إنسانيَّته بالذات بالمساءلة. ولقد كانت الخشية العظمى التي تسكنه هي الإضرار بالغير. أمَّا العدالة بهذا الاعتبار، فهي ليست مجرَّد مكافأة تمنُّ بها الأنا السائلة على سواها من أجل تمنحها الإجابة. العدالة عنده عطاءٌ مجانيٌّ تتجاوز ذاتها في سخاء بلا حدود طبقًا لما ورد في كتابه الأثير “هكذا تكلَّم زرادشت”: “أحب ذلك الشخص الذي يعطي دائمًا ولا يريد حفظ نفسه”.
السؤال الذي ينمو في واحديَّة المثنَّى يصير كلُّ شيء بالنسبة إليه قابلًا لسريان الزوجيَّة الخلَّاقة في الوجود. لقد صار الأمر بيّنًا لمن رأى نقيضه قائمًا في ذاته، وفي هذه الحال لا حاجة لأحدٍ من طرفي الزوجيَّة إلى البحث عن صاحبه في غير ذات زوجه، لأنَّ كلًّا من الزوجين النقيضين قائمٌ في ذات الآخر، وكلٌّ منهما يحسُّ بزوجه، ولولا رؤية كلٍّ من الباطن والظاهر قائمًا في الآخر لما استطاع الإنسان أن يتلاءم مع صروف الدهر، فيحيا النقيض في نقيضه، ليُعدَّ لكلِّ حال عدَّته مزوّدًا من غناه لفقره، ومن صحَّته لمرضه، ومن راحته لتعبه ومن شبابه لهرمه. وإذا كان الفردُ العاديُّ يحيا هذا التناقض فطرةً وسليقةً وطبعًا بحياته النقيضين معًا، فإنَّه على بصيرة من أمره، فكيف حياة أهل الغرام التي لا يعرفها إلَّا أصحابها، ولعلَّ السبب في غيابها عنَّا هو أنَّنا قد تجافينا عن فطرتنا، فلم نعش النقيض قائمًا في ذات نقيضه؟
ولهذا كان علمُنا بباطن الشيء يجعلنا نعلم ظاهره ضرورة وبداهة والعكس بالعكس[4]. ولنا في هذا مثال: فلو علمتَ أنَّ الحركة في كلٍّ من الزوجين النقيضين من كلِّ شيء، تنتهي وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، لوجدت أنَّ السبب في ذلك إنَّما هو من أجل أن تظلَّ مستمرَّة دائمًا وأبدًا. فالشيء المتحرِّك الذي تنتهي حركته في أحد الزوجين وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، إنَّما هي حركةٌ مستمرةٌ لا تتوقَّف، وفيها تتمثَّل الصلة بين الخالق والمخلوق،- وبين النظير ونظيره-، وذلك في صورة رحمته التي وسعت كلَّ شيء. وفي استمرار هذه الصلة المتبادلة على السواء والتعادل المتبادل، يتجلَّى سرُّ هذا الوجود في صورة قيام النهاية في البداية والبداية في النهاية في كلِّ شيء[5]. فإذا نظرت مثلًا إلى معنى التزاوج الذي يتَّجه إلى الاتِّصال مستقلًّا عن معنى التجاوز الذي يتجه إلى تعدي الشيْ الذي تتجاوزه منفصلاً عنه، وجدت أنه ليس إلى تعرّف أيٍّ منهما من سبيل إلَّا من خلال الآخر.
إذن، يقوم المثنَّى على رابطة التماثل والانسجام والتكامل. وأمَّا الاثنينيَّة فتقوم على جدليَّة التناقض؛ حيث ينفي الحقُّ وجود الباطل؛ لذا يدخل الحقُّ والباطل في علاقة تناقض، أمَّا وجود الأبيض في تضادٍّ مع الأسود، والصلة بينهما صلة تضادّ، فالحالتان المتضادَّتان إذا تتالتا، أو اجتمعتا معًا في نفس المدرك كان شعوره بهما أتمَّ وأوضح، وهذا لا يَصدق على الإحساسات والإدراكات والصور العقليَّة فحسب بل يصدق أيضًا على جميع حالات الشعور كالَّلذة والألم والتعب والراحة.. فالحالات النفسيَّة المتضادَّة يوضح بعضها بعضًا، وبضدِّها تتميَّز الأشياء، وقانون التضادِّ أحد قوانين التداعي والتقابل[6].
والتقابل (opposition) (هو علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخر، أو علاقة بين متحرّكين يقتربان سوية من نقطة واحدة، أو يبتعدان عنها، وفي المنطق يأخذ التقابل وجهين أحدهما تقابل الحدود، والآخر هو تقابل القضايا. فالمتقابلان في تقابل الحدود هما الَّلذان لا يجتمعان في شيء واحد، في زمان واحد، ويمكن التمييز هنا بين أربعة أقسام، أو أنواع من التقابل:
1- تقابل السلب والإيجاب مثل الشعور والَّلاشعور.
2- تقابل المتضايفين مثل الأبوَّة والبنوَّة.
3- تقابل الضدَّين مثل السواد والبياض.
4- تقابل العدم والملكة مثل العمى والبصر.
أمَّا تقابل القضايا فيطلق على القضيَّتين الَّلتين تختلفان بالكمِّ، أو بالكيف أو بهما معًا، ويكون موضوعهما أو محمولهما واحدًا، ولهذا التقابل أربعة أقسام أيضًا[7].
ـ التداخل عند اختلاف القضيَّتين بالكم فقط.
ـ التضادُّ عند اختلافهما بالكيف فقط.
ـ التضادُّ الفرعي عند الاختلاف بالكيف فقط شرط أن تكون كلٌّ من القضيَّتين جزئيَّة.
ـ التناقض عند الاختلاف بالكمِّ والكيف معًا[8].
وهكذا لا ترضى طبيعة العقل البشريِّ بالفصل، فحين تقوم بعمليَّة التقابل الثنائيِّ تضع الطرف الأول في حال تعارض مع الطرف الثاني، ومع أطراف أخرى تشترك معه في الحال، أو الصفة… لكنَّ هذين الطرفين إذا نظرنا إليهما على أنَّهما طرفا عصا فثمَّة ما يربط بينهما، ويشكِّل موقعًا وسطًا هو ما يمكن أن نسمّيه حال شبه التضادّ، أو العلاقة بين طرفي الثنائيَّة، فلا يرضى الدماغ البشريُّ عن الانفصال الناجم عن إقامة مثل هذا التقابل القطبيِّ، فيبحث عن موقع وسط”.[9] فثمَّة منطقة وسطى بين السالب والموجب في الفكر الفلسفيِّ تربط بين الطرفين، ويستطيع الدماغ البشريُّ أن يلتقط المنطقة الوسطى بين طرفي الثنائيَّة، أو الجزء الأوسط الواقع بين حدَّيها. وقد مثَّل كلود ليفي شتراوس لهذه العمليَّة بالإشارات الضوئيَّة، فثمَّة إشارة وسط بين الأحمر والأخضر تتيح مسافة للذهن البشريِّ؛ ليتهيَّأ، والفعل البشريُّ هو الذي يختارها[10]. وعليه يشترط في الضدَّين أن يكونا من جنس واحد كالَّلذة / الألم “هما من الكيفيَّات النفسيَّة الأوليَّة، فليست الَّلذة خروجًا من الألم، ولا الألم خروجًا من الَّلذة، بل الَّلذة والألم كلاهما وجوديَّان، ولكلٍّ منهما شروط خاصَّة تدلُّ على أنَّهما إيجابيَّان”[11] والإيجاب / السلب “والإيجاب عند الفلاسفة هو إيقاع النسبة وإيجادها، وفي الجملة هو الحكم بوجود محمول لموضوع، وهو نقيض السلب، كما أن الإثبات هو نقيض النفي”[12].
وتشكل الأضداد ما يسمى بقانون وحدة الأضداد وصراعها، فكل شيء يحتوي على أضداد، ووحدة الأضداد نسبية، وصراعها مطلق، وهو قانون “مطلق للواقع، وفهمه بالعقل الإنساني يعبر عن ماهية الجدل المادي ولبّه.. وصراع الأضداد يعني أن التناقض داخل ماهية شيء ما يتم حلُّه بشكل دائم، ولما كان يُعاد تقديمه بشكل دائم فإنَّه يتسبَّب في تحويل القديم إلى جديد… وقد فسَّرت الماركسيَّة، وعرفت قانون وحدة الأضداد بأنَّه قانون المعرفة، وقانون العالم الموضوعيّ”[13].
أمَّا الضدّيَّة في المثنَّى فهي تعني وجود أمرين متضادَّين مرتبطين برباط واحد، وهو مبدأ يقوم عليها إيقاع الكون ونظامه، فالنور والظلمة في النهار والليل ثنائيَّة ضديَّة يجمعها اليوم، والفرح والحزن متضادَّان، ويختفي أحدهما وراء الآخر، وكذلك النجاح والفشل، والغنى والفقر، والعلم والجهل…. لكن العلاقة بين الثنائيَّات الضديَّة علاقة تضادّ؛ أي تواز بين طرفي الثنائيَّة، أمَّا علاقة التناقض فتقوم على النفي، فوجود طرف ينفي وجود الطرف الآخر[14].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – باروخ سبينوزا – علم الأخلاق – ترجمة: جلال الدين سعيد – المنظَّمة العربيَّة للترجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العربيَّة – بيروت – 2009 – ص 35.
[2] – فريديريك نيتشه – ما وراء الخير والشر – ترجمة جيزيللا فالور حجار، إشراف: موسى وهبه – إصدار دار الجديد – بيروت 1995 – ( ص 18).
[3] – المصدر نفسه – ص (20).
[4] – محمد عنبر – مقدِّمة لديوان العارف بالله العلَّامة الشيخ أحمد محمد حيدر “النغم القدسي” – دار الشمال – طرابلس – لبنان – 1997 – ص(18).
[5] – المصدر نفسه – ص (20).
[6] – المعجم الفلسفي، ص 285.
[7] – سمر الديوب – الثنائيَّات الضديَّة – بحث في المصطلح ودلالاته – المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّة – بيروت – 2018 – ص 18.
[8] – المرجع السابق، ص 318- 319.
[9] – إدموند ليتش: 2002، كلود ليفي شتراوس دراسة فكريَّة، ترجمة: د. ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص 24.
[10– المرجع السابق، ص 25.
[11] – المعجم الفلسفي، ص126.
[12] – المرجع السابق، ص 179.
[13– الموسوعة الفلسفيَّة، ص373.
[14] – سمر الديوب – مصدر سبق ذكره – ص 21.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
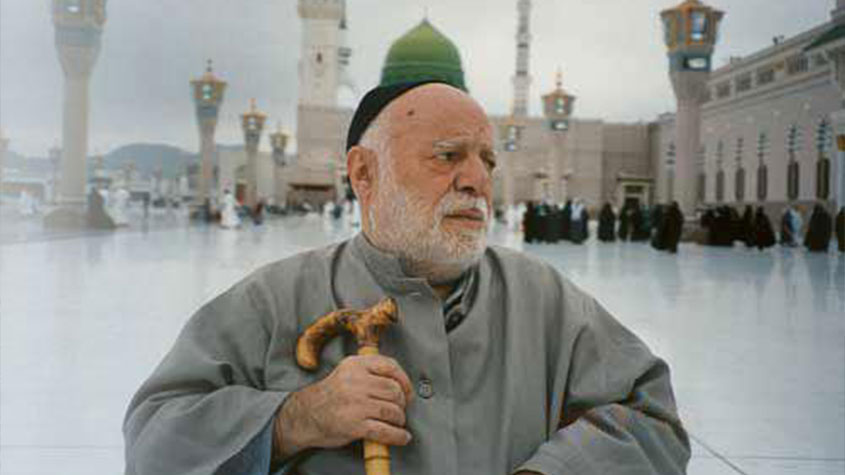 معنى (خفى) في القرآن الكريم
معنى (خفى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 كيف تُرفع الحجب؟
كيف تُرفع الحجب؟
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
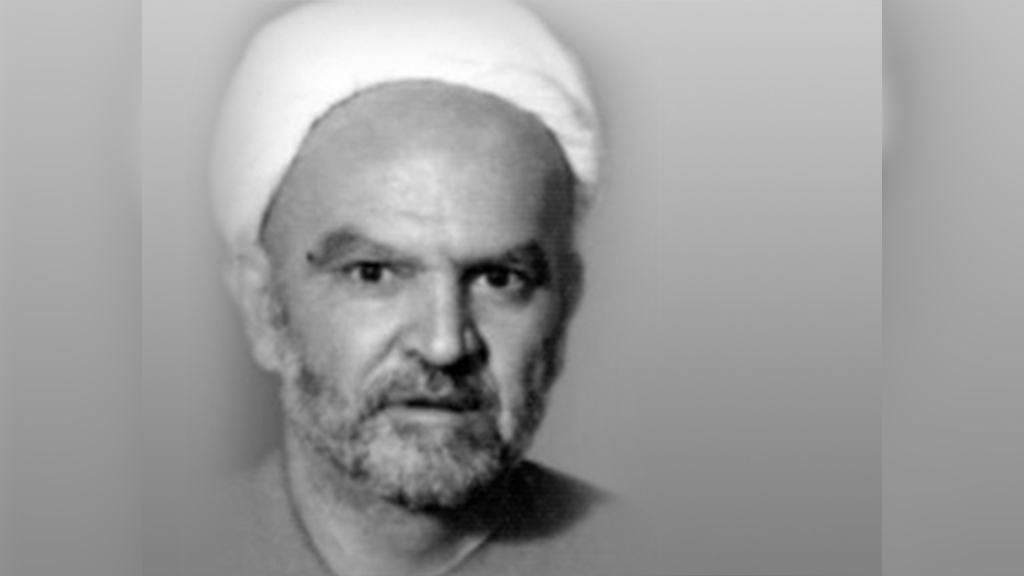 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
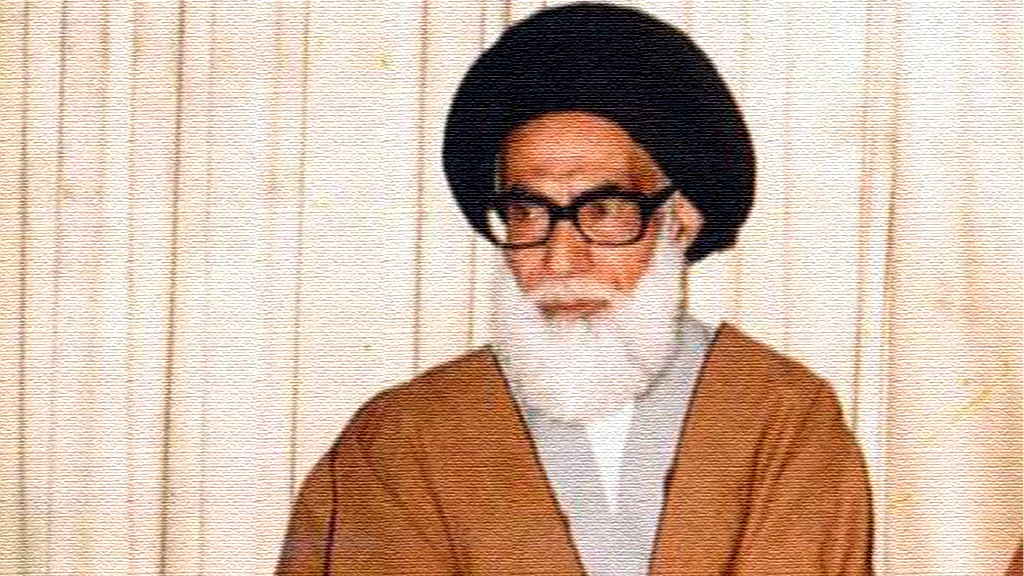 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
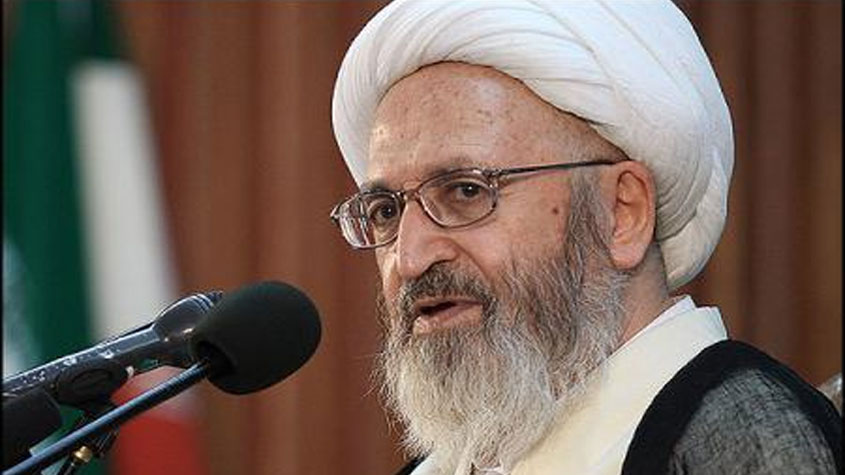 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
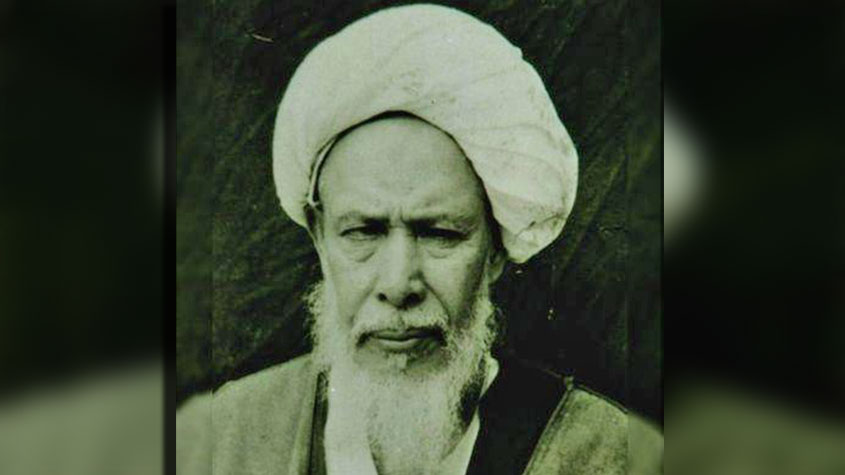 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-
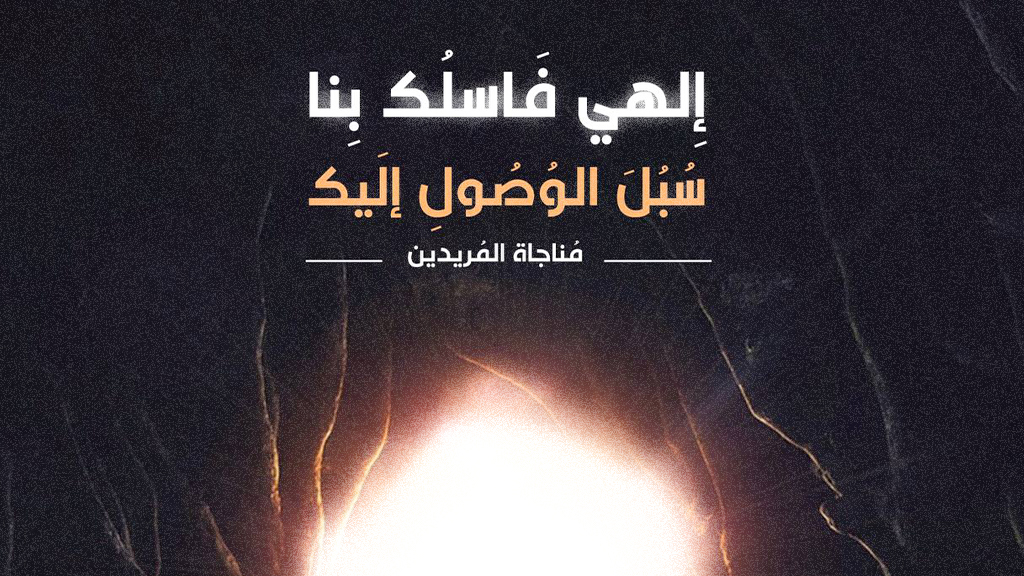
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-
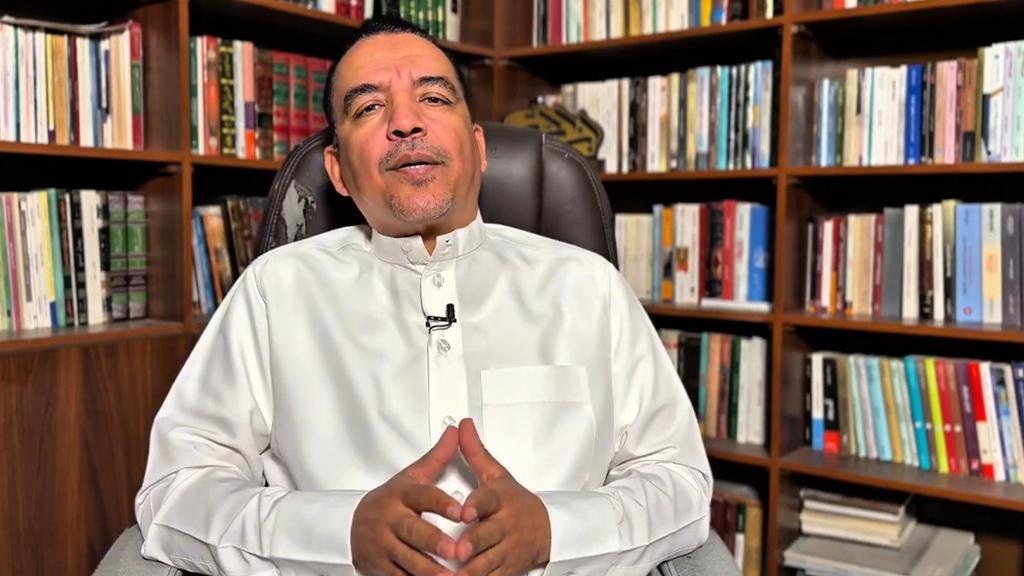
زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ
-
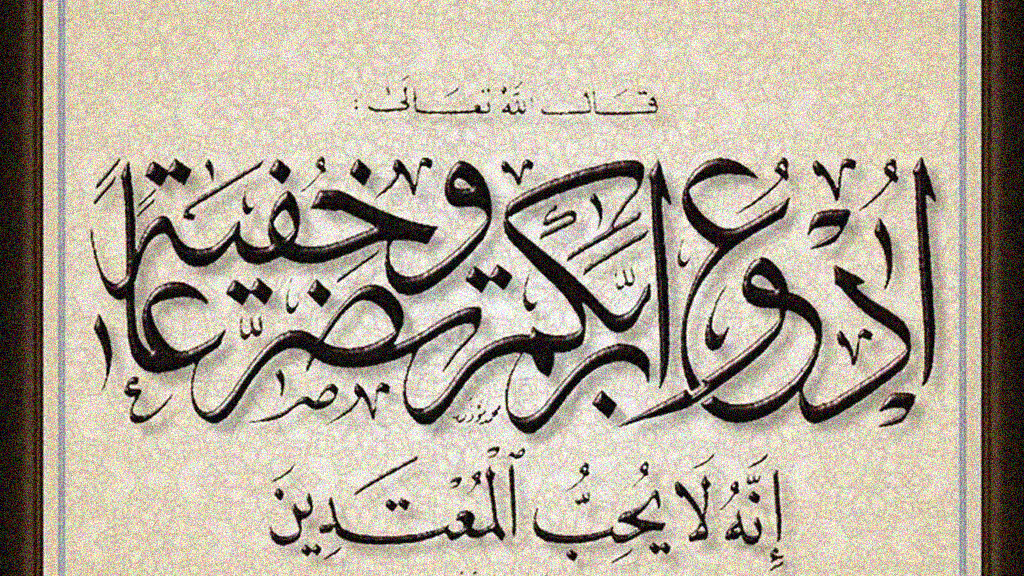
معنى (خفى) في القرآن الكريم
-

التجارة حسب الرؤية القرآنية
-
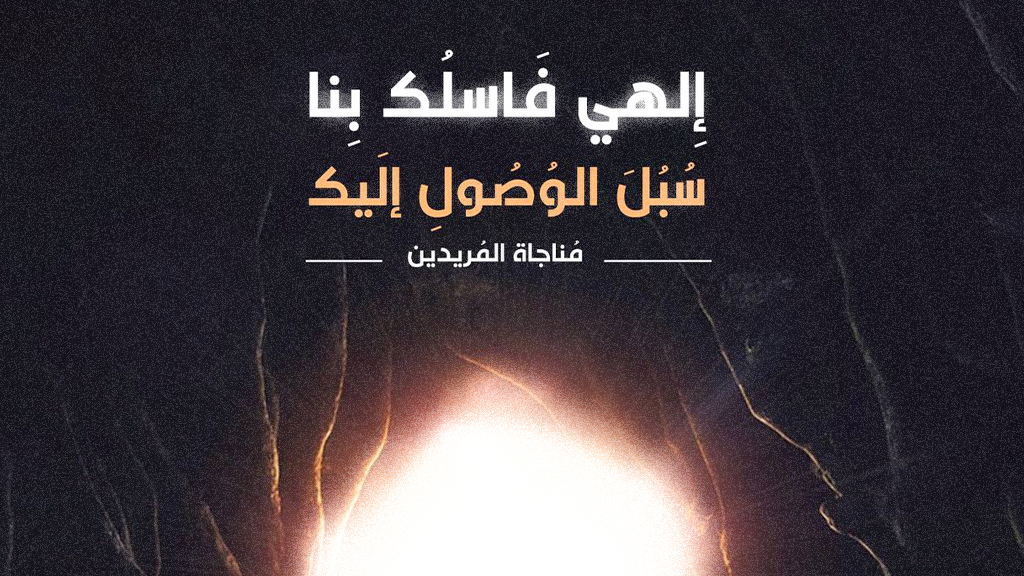
مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك