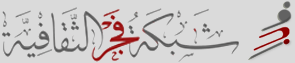علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".بالإيحاء.. كان الوجود كلّه (4)

الوحي الجامع لمعرفة الله ومعرفة الكون
في مقام المعرفة الوحيانيَّة يتوسَّع أفق التنظير والاستشعار، حتى لنجدُنا تلقاء مساعٍ فريدة تتغيَّا الخروج من العثرات التي تحول دون الأجوبة الآمنة. هنا نذكِّر بقاعدتين تؤلِّفان واحدًا من أبرز التنظيرات التي عَنِيَت بمعرفة الموجود البَدْئيِّ استنادًا إلى الوحي. وهاتان القاعدتان هما “علم كان” و “علم البَدء” اللتان ذكرهما ابن عربي في جواباته على أسئلة الحكيم الترمذيّ:
– القاعدة الأولى- علم “كان”: المقصود من هذا العلم تنزيه الله تعالى عن كلِّ ما سواه من أشياء الكون لقوله تعالى: (لَيسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ) [الشورى- 11]. يقرِّر علم “كان” أنَّه سبحانه لا تصحبُه الشّيئيّة، ولا تنطبق عليه.. وأمَّا لفظة (كان) فلا تدلُّ على التّقييد الزمانيِّ، فالمراد بها الكون الذي هو (الوجود). ولذلك فُهِم حرف “كان” على أنَّه حرف وجوديٌّ، لا فعلٌ يطلُب الزمان. وعليه، كان تقرير الشيخ ابن عربي حول علم “كان” أنَّ الله موجود، ولا شيء معه. أي ما ثمّ من وجوده واجب لذاته غير الحقّ. والممكن واجب الوجود به لأنَّه مظهره، وهو ظاهر به. والعَيْن الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها.. فانْدَرج الممكن في واجب الوجود لذاته “عَيْنًا”، واندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن “حُكمًا”..
– القاعدة الثانية: علم البَدء: لا ينأى هذا العلم عن علم “كان” في منظومة ابن عربي، بل هو الحلقة التالية في علم التوحيد وفعل الوحي. فإذا كان “علم كان” يعني الإقرار بالذات الأحديَّة وتنزيهها عن الفقر والإمكان، فإنَّ “علم البَدء” هو الإقرار بحاصل الكلمة الإلهيَّة “كُن”. أي بالموجود البَدْئيَّ كأول تجلٍّ إلهيٍّ في دنيا الخلق. وعلى هذا الأساس يُعرَّف بأنَّه علمُ الفصل بين الوجودين، القديم والمُحدث. وهو حسب ابن عربي علم عزيز وغير مقيَّد، وأنَّ أقرب ما تكون العبارة عنه، أن يُقال: البَدْء افتتاح وجود الممكنات على التّتالي والتّتابُع، لكون الذات الموجِدة له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان. فالزمان من جملة الممكنات الجسمانيَّة، وهو لا يُعقل إلَّا ارتباط ممكن بواجب لذاته. فكان في مقابلة وجود الحقِّ، أعيان ثابتة، موصوفة بالعدم أزلًا، وهو الكون، الذي لا شيء مع الله فيه، إلَّا أنَّ وجوده أفاض على هذه الأعيان، على حسب ما اقتضته استعداداتها، فتكوَّنت لأعيانها، لا لهُ، من غير بينيَّة تُعقَل أو تُتَوَهّم. فوقعت في تصوُّرها “الحَيْرة” من طريقين: طريق “الكشف”، وطريق “الدليل الفكريّ”.
والنُّطق عمَّا يقتضيه الكشف، بإيضاح معناه، يتعذَّر: فإنَّ الأمر غير مُتخيَّل، فلا يُقال، ولا يدخُل في قوالب الألفاظ. وسبب عزَّة ذلك، يعود إلى الجهل بالسبب الأول وهو “ذات الحقّ”. والذي وصل إليه علمُنا من ذلك – وَوَافَقنا الأنبياء عليه – كما يضيف ابن عربي- أنَّ “البدء عن نسبة أمْر، فيه رائحة جَبْر”. إذ الخطاب لا يَقَع إلَّا على عَيْن ثابتة، معدومة، عاقلة، سميعة، عالمة بما تسمع: بسَمْع ما هو سمع وجود، ولا عقل وجود، ولا علم وجود. فالْتَبست، عند هذا الخطاب بوجوده. فكانت “مَظْهرًا له” من اسمه (الأول-الظاهر). وانسحبت هذه الحقيقة، على هذه الطريقة، على كلِّ عَيْن إلى ما لا يتناهى.. فإنَّ مُعطي الوجود لا يُقيِّده ترتيب الممكنات، إذ النسبة منه واحدة. فالبَدْء ما زال، ولا يزال. وكلُّ شيء من الممكنات له عين الأوليَّة في البدء. ثُمّ إذا نُسبت الممكنات، بعضها إلى بعض، تعيَّن التقدُّم والتأخُّر، لا بالنسبة إليه سبحانه.. فوقف “علماء النَّظر” مع ترتيب الممكنات، حيث وَقَفنا نحن مع نسبتها إليه تعالى..
يُستفاد من هاتين القاعدتين العلميَّتين السابقتَيْ الذكر، أنَّ الوحيَ حاضرٌ فيهما حضور المطابقة والتناسب. وبيان الأمر أنَّ العلم بكلٍّ منهما له سعته الخاصَّة ومقداره الخاصُّ، ذلك بأنَّ مهمَّة الوحي في هذه المنزلة، تعليميَّة وتعريفيَّة. تعليم الأنبياء القانون الإلهيّ بالوحي المباشر، وتعريف الناس بهذا القانون عن طريق الخبر وأحكام الشريعة.
علم الوحي.. خفاء وبداء ومسرَّة
علم الوحي في مقام الذات الأحديَّة المقدَّسة هو علم مخصوص بنفس المقام، ولا يعلم سِرَّه إلَّا هو. وفي مقام الموحَى إليه هو علم دالٌّ على المعرفة بفعل الفاعل أمرًا وخلقًا وتدبيرًا. فالمعرفة من هذه الجهة هي معرفة معنيَّة بالمخلوق، بدءًا من الذرَّة البدائيَّة وحتى الإنسان الكامل. لهذا قيل إنَّ معرفة الموحَى إليه علمٌ من الدرجة الثانية لأنَّها مختصَّة بالعلم الهادي إلى عالم الخلق. ومثل هذا العلم لا يُنال إلَّا بتعيُّن الموجودات وظهورها بوصف كونها علامات دالَّة عليها. وحالذاك، نغدو تلقاء علمٍ تفصيليٍّ حيث تكون فيه المعرفة من جنس العلم وعلى نحو لا تُنجز معرفة المخلوقات إلَّا بربطها بأصلها، وبما يفيض عليها ذاك الأصل.
ومن قبيل الإيضاح نقول، إنَّ أهل المعرفة إذا أرادوا معرفة أمرٍ ما، فإنَّما يعرفونه بحكم من أحكام العلم الأول أو بصفة من صفاته. بل إنَّ كلَّ محصَّلٍ من المعرفة إنَّما يحصَّلُ بالعلم الموحى به لا بغيره. وهنا منشأ التمايز بين العلم والمعرفة. فالمعرفة – كما يبيِّن العارفون – أخصّ من العلم، وهي تطلق على معنَيَيْن: الأول، علم بأمرٍ باطن يُستدلُّ عليه بأثر ظاهر، كما لو توسَّمت شخصًا ما، فعلِمتَ باطن أمره من علامة ظهرت على سيماء وجهه أو على لسانه. والثاني، العلم بمشهودٍ شاهدته وسبق به عهد: كما لو رأيتَ شخصًا كنت رأيتَه من قبل، فعلمِتَ أنَّه هو ذلك المعهود.
يشير المعنى الأول للمعرفة إلى المنطقة الباطنيَّة للإدراك التي يستدلُّ عليها بما هو ظاهر من الشيء أو الشخص. ويومئ المعنى الثاني، إلى الاستذكار والانتباه من بعد نسيان أو غفلة. وهو الحال الذي يحدث إثر حصول اليقظة لدى الإنسان، وبناءً على هذا الفهم، سمِّي العارف عارفًا لأنَّه عرف ربَّه من بعد نسيان وغفلة، لا من بعد جهل به. ولبيان المزيد، نشير إلى المعرفة الفائقة التي يحوزها العرفاء لدى بلوغهم مقام التلقّي غير المباشر من الغيب. أي المقام الذي به ينالون حظًّا ما من سرِّ العلم البادي على صورة معارف تفصيليَّة.
والمقصود من سرِّ العلم كما يلاحظ صدر الدين القونويُّ هو معرفة التوحيد في مرتبة الغيب. فيطَّلع المشاهد على العلم ومرتبة وحدته بصفة وحدة، ليدرك بهذا التجلِّي العلميِّ من الحقائق ما شاء الحقُّ تعالى أن يُرِيَه منها ممَّا هي في مرتبته أو تحت حيطته. وعليه، فإنَّ كلَّ ما يصل إليه المتعرِّف الوحيانيُّ من معرفة كان مرجِعُه إلى الغيب. فالمعرفة التوحيديَّة هي ثمرة كلمة الوحي في تحقُّقها الوجوديّ. وهي معرفة تعرفُها الموجودات غير الناطقة بغريزتها التكوينيَّة، كما يعرفها الإنسان المتكلِّم بالفطرة والخبرة والشهود العقليُّ والاستشعار الباطنيّ.
ولو شئنا التمييز بين مراتب معرفة الوحي فسنجدها على وجهين: أولهما، معرفة الشيء بالكنه والحقيقة على ما هو عليه في ذاته وواقعه. وثانيهما، معرفة الشي بالوجه، أي اقتصار معرفته فقط على وجه الخصوص، وهذا هو حال عامَّة البشر. أمَّا حقيقة الوحي في ذاته فهو مما لا تناله العقول ولا تحويه الألفاظ. على حين أنَّ النبيَّ يتلقَّى الوحي من غير توسُّط الحواسِّ الظاهرة، فيسمع ويرى من غير وساطة السمع والبصر الماديّين.
هذه المسألة في وعي طبيعة الوحي الخاصِّ والمباشر، وأنَّه حاصل الاتصال الغيبيِّ بين النبيِّ وعالم الملكوت والجبروت، قد تفضي إلى تعذُّر الفهم العقلانيِّ لظاهرة الوحي النبويِّ أو إمكانيَّة تحليله في ضوء التجربة العلميَّة. ومن البيِّن أنَّ الذين عكفوا على فهم الوحي في ضوء المنطق العقليِّ المحض أو التجربة العلميَّة المخبريَّة لم يصيبوا؛ ثمَّ لم يبرحوا كهف الأذهان وحسابات العقل الأدنى. ذلك بأنَّهم طلبوا المعرفة ممَّا يقع خارج دائرة مجالهم الإدراكيّ. فالخفاء في طبيعة الوحي، هو الذي جعل البعض ينكرونه مطلقًا، أوانهم ينكرونه خصوصًا بمفهومه الغيبيِّ ويلبسونه ثوبًا علميًّا، فحيث عجزوا عن تحليل ظاهرة الوحي كنوع متميّز من أنواع الإدراك، حاولوا أن يحلِّلوه ويدرسوه في ضوء ما توصَّل إليه العلم الحديث من معطيات تجريبيَّة ليسهل عليهم الاعتقاد به.
في الميتافيزيقا الوحيانيَّة ما يفيد أنَّ عدم فهْم حقيقة الاتّصال الروحيِّ الخفيِّ بين المَلأ الأعلى وجانب الإنسان الروحيِّ لا يعني إنكار هذا الاتِّصال. فالإنسان يتلقَّى بروحه إفاضات وإشراقات نوريَّة تشعُّ على نفسه من عالَم وراء هذا العالم المادّيّ، وليس في ذلك اتّصالًا أو تقاربًا مكانيًّا؛ لكي يستلزم تحيُّزًا في جانبه تعالى. ولعلَّ منشأ هذه الشبهة قياسهم أمور ذاك العالم غير المادّيِّ بمقاييسَ تخصُّ العالم المادّيّ. وبهذا يتَّضح أنَّ الوحي ليس أمرًا ممكنًا فحسب، بل هو أمرٌ واقع أيضًا. والوقوع هنا يجري على نحو الأصالة الإيجاديَّة في مقام الأمر والخلق. ذلك خلافًا للذي تصوَّره أهل العقل الأدنى إذ اعتبروا أنَّ الوحي من خصيصة الملائكة، ولا ينكشف للبشر لامتناعه الذاتيّ.
ما من ريب، أنَّ التأصيل الجوهريِّ لمعنى الوحيانيِّ في حضوره وتبدِّيه في الواقع، يفضي إلى حقيقة أنَّ الإنسان – بوصفه إنسانًا – هو كائنٌ ميتافيزيقيٌّ لا يستطيع العيش إلَّا في عالمٍ مرعيٍّ بالألوهيَّة. فالإنسان الوحيانيُّ الذي يؤسِّس وجوده وفقًا لعالم الرعاية الإلهيَّة، هو الأكثر توقًا إلى العيش في محاريب التوحيد. بل هو ذاك الذي أصغى إلى نداء العالم السماويِّ من أجل أن يتلقَّى ما قُدِّر له من ألطاف الوحي وشهوده. وحالذاك لا يعود العارف يرى إلى حقيقة الوحي إلَّا كونه واقعًا حقيقيًّا يمنحه الشعور بالامتلاء المحض وبالسعادة التي يتأمَّلها بشغفٍ رضيّ، ثمَّ ليرجو منتهاه إلى المكان الأعلى طهرًا وتقدُّسًا، مثلما كان على الفطرة من قبل، كائنًا طهرانيًّا في علم الله وحضرته القدسيَّة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القرآن والحياة في الكرات الأخرى
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
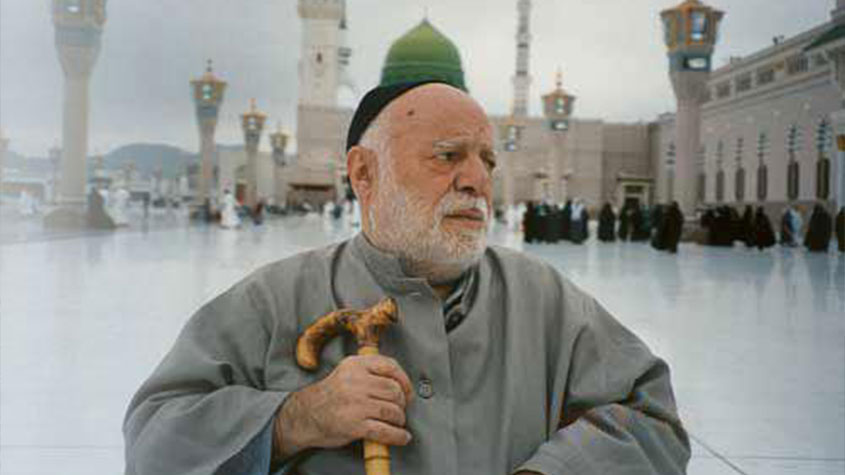 معنى (كدح) في القرآن الكريم
معنى (كدح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
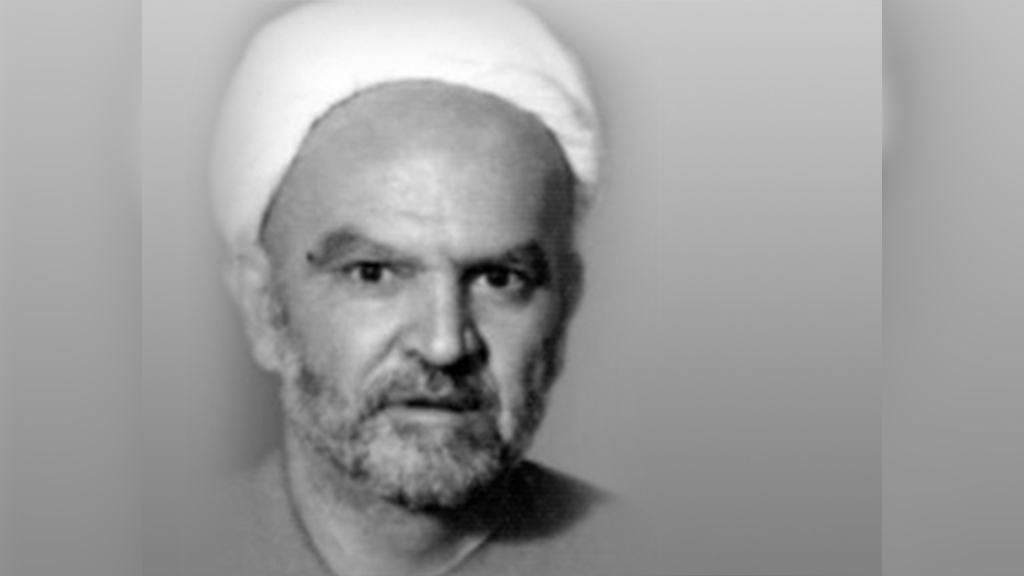 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
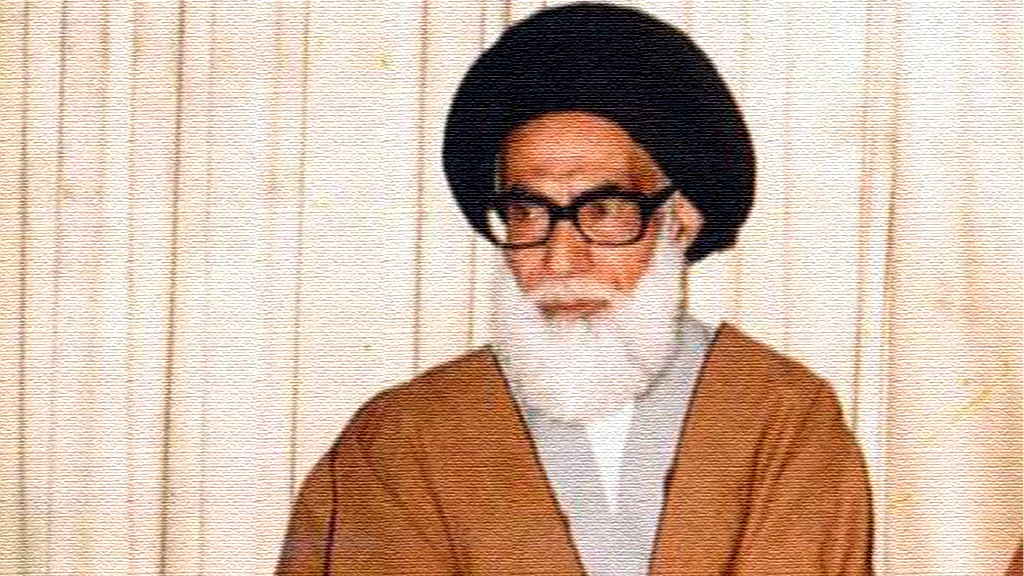 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
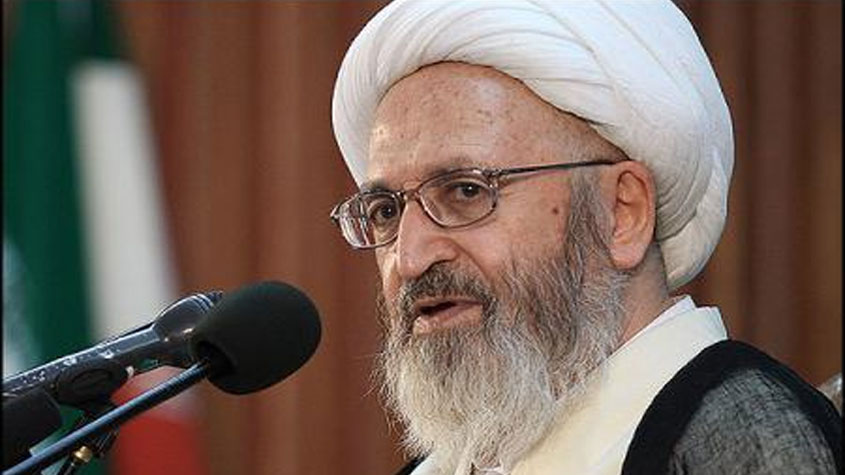 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
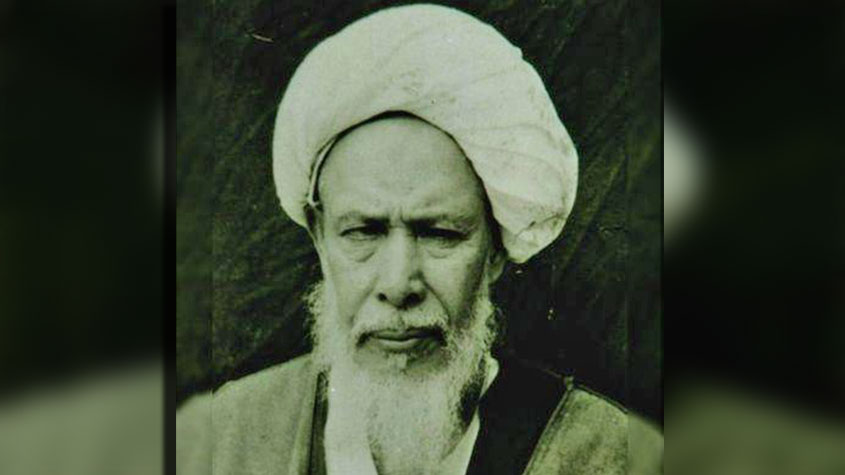 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

خلاصة تاريخ اليهود (2)
-
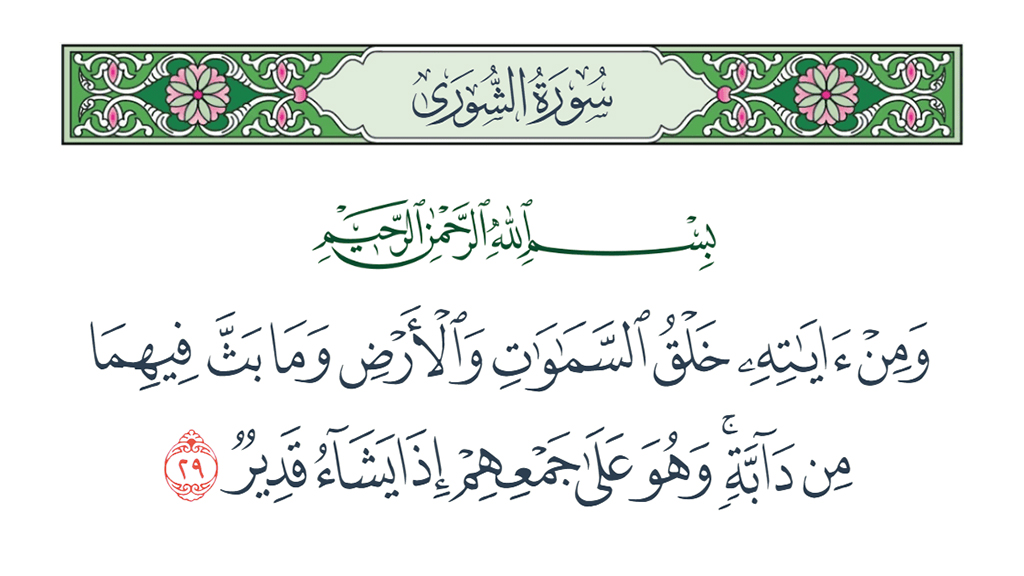
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
-
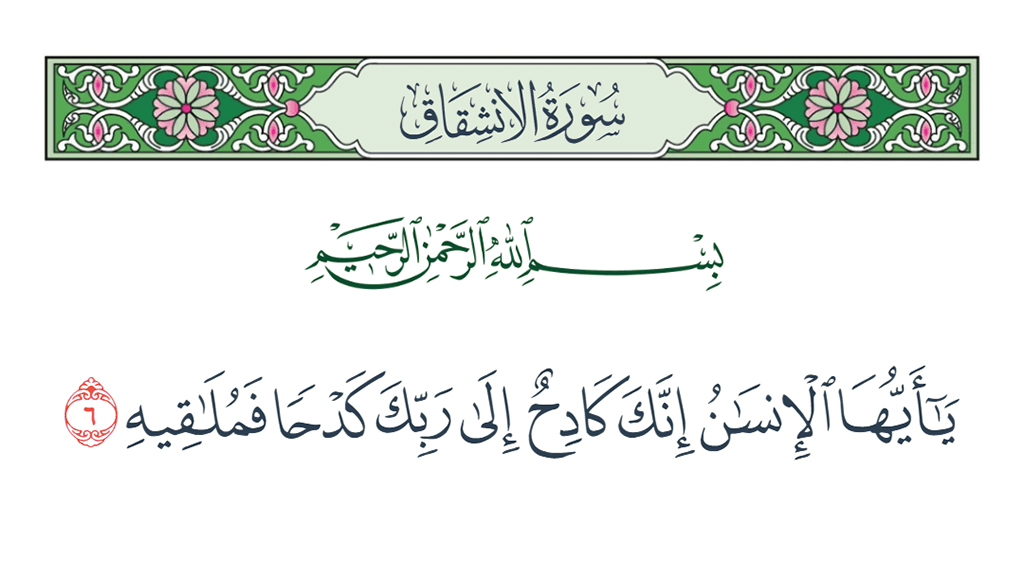
معنى (كدح) في القرآن الكريم
-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-
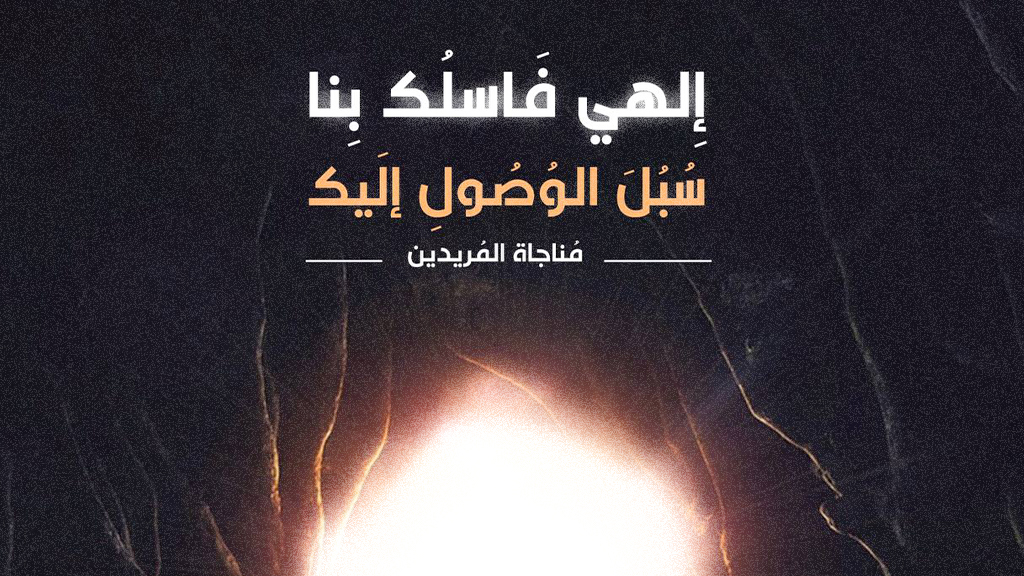
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-
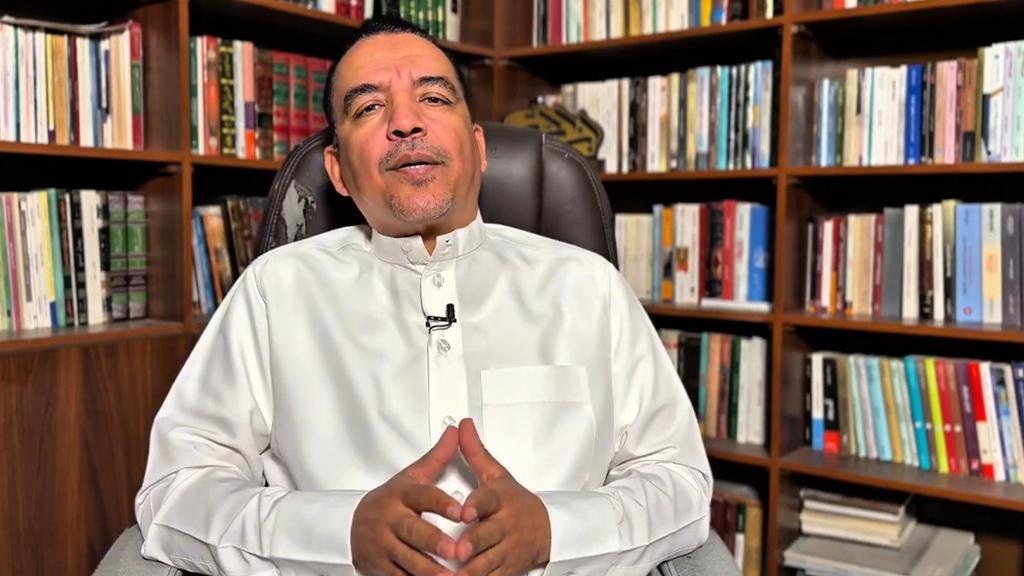
زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ