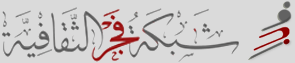قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (2)
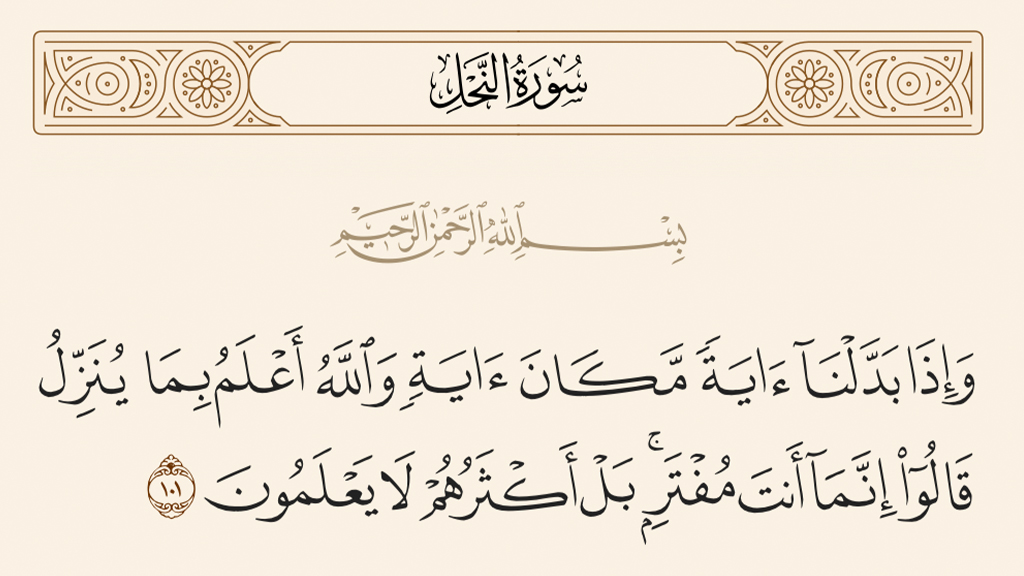
تعليقات نقديّة على علاقة آية التبديل بفكرة النسخ
كان هذا هو المشهد الذي أعطى جمهور مفسّري الإسلام صورةً واضحة في دلالة هذه الآية على النسخ، لكن في المقابل، ثمّة تساؤلات وملاحظات يمكن طرحها، وأهمّها:
أ ـ الموقف من التفاسير القديمة وما جاء في أسباب النزول
إنّ تفاسير قدامى المفسّرين هنا ليست ـ لو سلّمنا بدلالة كلّ النصوص المنقولة عنهم على موضع النسخ هنا ـ بالذي يشكّل تياراً واسعاً في السياق التفسيري في القرن الأوّل والثاني الهجريّين؛ لأنّ حجم النصوص المنقولة عنهم قليلة للغاية، فليس بيدنا إلا مجاهد بن جبر (104هـ) وقَتَادة بن دَعامة الدوسي (118هـ) وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي (127هـ) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (182هـ)، والبقيّة لم يتعرّضوا للموضوع. وليس في الصحابة من نقل عنه شيء مثل هذا في خصوص هذه الآية الكريمة. هذا لو تغاضينا عن مديات إمكان إثبات ما نُقل عن هؤلاء الأربعة.
أمّا رواية ابن عباس التي تفرّد بنقلها الواحدي (468هـ) دون إسناد، وبعده الطبرسي كذلك، ولعلّه أخذها منه، ولا نعرف قبلهما من نقل هذا عن ابن عباس، فمن الصعب التأكّد منها، مع هذا الفاصل الزمني الطويل. وأمّا رواية تفسير القمي، فأمرها أوضح بعد عدم ثبوت نسبة هذا التفسير للقمي، والتباس أمره جدّاً كما حقّقناه في محلّه.
وعليه، فالشواهد التاريخيّة والنزوليّة الحافّة هنا ليست بتلك المثابة التي تفرض علينا الأخذ بها وتفسير الآية على وفقها. وهذه الملاحظة لا تُبطل دلالة هذه الآية على النسخ، بل تسحب من يد القائل بدلالتها أحدَ العناصر المرجّحة لتفسيرها بالنسخ لا غير.
لكن بعيداً عن النقاش المشار إليه، ولنأخذ الصورة التي قدّمها لنا نقل ابن عباس وأوضحها الواحدي النيسابوري، ولنقم بتحليل المشهد تاريخيّاً. إنّ هذه الصورة تعني أنّ النبيّ كان يعدّل من مواقفه وتوجيهاته ويبدو أنّ ذلك لم يكن في مرّة أو مرّتين، بل كان يتكرّر مراراً وتكراراً، والسؤال لماذا افترض المشركون أو أهل الكتاب أنّه مفترٍ بعد ظواهر النسخ هذه؟! بعبارة أخرى: ما هي العلاقة المنطقيّة المتصوّرة في ذهنهم بين النسخ وبشريّة القرآن حتى افترضوا أنّ النسخ ينفي صفة الإلهيّة عن القرآن الكريم؟
من الواضح أنّهم يعتبرون أنّ الله هو العالم المطلق الذي لا حدّ لعلمه ولا لحكمته ولا لقدرته، وأنّ شخصاً من هذا القبيل لا معنى لأن يُجري أحكاماً ثم يعدّلها ثم يغيّر فيها وهكذا، فهذه العمليّة من شؤون التجارب البشريّة، وليست من شؤون الله سبحانه، فَنَقَلَهُم هذا التصوّر من ظاهرة النسخ إلى ظاهرة البشريّة، وبخاصّة مع تعبير الواحدي النيسابوري بما يفهم منه وقوع الاختلاف داخل القرآن وهو ـ في الجملة ـ مؤشّر البشريّة كما يقول القرآن نفسه (النساء: 82). ويتعزّز هذا الأمر بما سيأتي لاحقاً من أنّ التبديل هنا هل هو بمعنى النسخ الاعتباري الحكمي، أو أنّه بمعنى نسخ التلاوة بمعنى حذف آية تماماً من القرآن ووضع أخرى مكانها؟ الأمر الذي يزيد من إثارة حفيظة المشركين وأهل الكتاب، فيصبح حال النبيّ كحال شخص يصنّف كتاباً وفي كلّ يوم يغيّر مقطعاً، ثم يأتي بغيره الذي هو أحسن منه، أو كالشاعر الذي يواصل نحت شعره في مدّة زمنية طويلة فيغيّر ويبدّل حتى يخرج شِعرُه بأجمل حلّة.. أليس إشكال المشركين صحيحاً من الناحية العقلائيّة ومنطق الأشياء بل ومنطق القرآن نفسه؟
والجواب هو ما تقدّم في ظاهرة حكمة النسخ من حِكَم للنسخ ترفع هذه الفرضيّة وتعيق الجزم بها، غير أنّ اللافت أنّ القرآن الكريم لم يتكلّم ـ في مقام الجواب هنا ـ عن جواب مباشر، بل أعاد تكرار التأكيد على وحييّة القرآن الكريم، والتركيز على جهل أكثر الناس في مقابل علم الله سبحانه، ثم لفت النظر إلى أنّ بشريّته تتطلّب أخذ محمّدٍ من غيره، والمفروض أنّ لسان هذا “الغير” أعجمي والقرآن لسانٌ عربيّ مبين، مع أنّ القرآن الكريم كان من المناسب له هنا بيان العلّة في عمليّات التبديل هذه! هذا الأمر له صلة تارةً بالعنصر التعبّدي في النصوص الدينيّة وأخرى بأسلوب الحكيم الذي استخدمه القرآن مراراً وتكراراً، والتفصيل في محلّه.
واللافت في الآيات هنا أنّها تجعل القرآن تنزيلاً من الروح القدس بهدف تثبيت الذين آمنوا بما قد يوحي بأنّ عمليّة النسخ لها تأثيرات إيجابيّة تثبيتيّة على خصوص الذين آمنوا، وإن أوجبت ارتباكاً عند غيرهم.
ب ـ حول مكيّة آية التبديل والمشكلات القائمة
إنّ هذه الآية من آيات سورة النحل، والمعروف في التاريخ الإسلامي وعلوم القرآن أنّ سورة النحل مكيّة، فيبدو أنّ الكافرين الناقدين لرسول الله هنا هم قريش والمشركون، ولا علاقة للموضوع باليهود الذين أبدوا تشدّدهم في النسخ، بل ربما يقال بأنّه لا دليل على وجود نقاش يهودي في تلك الفترة حول النسخ، وأنّ القول بامتناع النسخ في الوسط اليهودي ـ نقداً على الإسلام ـ جاء لاحقاً. وهذا يعني أنّنا أمام مشكلة في دلالة الآية الكريمة، ففي مكّة لم يكن هناك تشريعات تفصيليّة حتى تعرضها ظاهرة النسخ، وعمدة ما جاء في النص المكّي هو تشريعات أصليّة كليّة عامّة يعلم عدم نسخها في القرآن الكريم، فكيف نفسّر الآية بالنسخ في سياقٍ مكّي؟! وبعد التفاتي لهذه الإشكاليّة، لاحظت أنّ الشيخ جمال الدين القاسمي قد ألمح إليها، كما سوف يأتي عند التعرّض لتفسيره لآية التبديل.
بل يتضاعف الإشكال عندما نلاحظ من خلال نصوص قدماء المفسّرين المنقولة عنهم وأسباب النزول أنّ هذه كانت ظاهرة، وأنّ رسول الله كان يتكرّر منه الأمر بشيء ثمّ تغيير الموقف منه، مما يؤكّد أنّنا أمام ظاهرة قرآنيّة، فكيف يمكن فهم وجود ظاهرة قرآنية (من خلال كلمة: آية) في ظلّ سياق مكّي؟!
لكنّ هذه الملاحظة قابلة للجواب، فإنّه إذا لم نرجّح في تفسير الآية أنّ لها علاقة بالنسخ، فلا حاجة لهذا الإشكال من رأس، وأمّا لو رجّحنا أنّ لها علاقة بالنسخ فهذا الترجيحُ بنفسه كافٍ في جعل هذه الآية مدنيّة. وعنوان المكّي والمدنيّ ليس من العناوين القطعيّة دائماً في التراث الإسلاميّ.
يُضاف إلى ذلك أنّ سورة النحل نفسها لم يثبت كونها مكيّة برمّتها، بل قد ذكر المفسّرون أنّها بين مكّي ومدنيّ، ففي نصٍّ معبّر عن هذا المشهد يقول الطبرسي: «أربعون آية من أوّلها مكيّة، والباقي من قوله: (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم) إلى آخر السورة مدنيّة، عن الحسن، وقتادة. وقيل: مكيّة كلّها غير ثلاث آيات، نزلت في انصراف النبيّ من أحُد (وإن عاقبتم فعاقبوا) إلى آخر السورة، نزلت بين مكّة والمدينة، عن ابن عباس، وعطا، والشعبي. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس: بعضها مكّي، وبعضها مدنيّ، فالمكّي من أوّلها إلى قوله: (ولكم عذاب عظيم)، والمدنيّ قوله: (ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) إلى قوله:(بأحسن ما كانوا يعملون)»[1].
هذا النصّ المكثّف يشرح لنا وجود انقسام حادّ في ما هو المكّي والمدني من سورة النحل، فعلى الرأي الأوّل تكون الآية التي نحن فيها مدنيّة؛ لأنّها الآية رقم: 101 من سورة النحل، أي وقعت بعد الآية الأربعين منها. أمّا على الرأي الثاني فتكون هذه الآية التي نحن فيها مكيّة؛ لأنّ المفروض أنّ آخر ثلاث آيات فقط مدنيّة، وعدد آيات سورة النحل 128 آية، أمّا على الرأي الثالث فهي مكيّة أيضاً؛ لأنّ شروع المدنيّ يقع في الآية رقم: 95، وينتهي عند الآية 96، ثم يعود النص المكّي فتقع الآية رقم: 101، ضمن القسم المكّي.
وبهذا نجد اضطراباً في المكّي والمدني، الأمر الذي يجعل مثل هذه الإشكاليّة غير واضحة، بل لعلّ تعبير “الروح القدس” بعدها وأمثاله يشي بنوعٍ من المقاربة مع الفضاء الذي يعرفه أهل الكتاب فيقرّب الآية من الفضاء المدني والله العالم.
وعليه، فهذه الملاحظة غير صحيحة أو فلنقل: غير قادرة لوحدها على إرباك الموقف، غير أنّها تصلح تساؤلاً جادّاً في وجه من قال بمكيّة هذه الآية، مثل الدكتور مصطفى زيد[2]. إلا إذا قال بأنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الآية هو وقوع النسخ ولو مرّة واحدة فيكون الأمر سهلاً، وبخاصّة لو وقع أواخر العهد المكّي الذي بدأت فيه ـ تحقيقاً أو توقّعاً ـ أولى الاحتكاكات مع أهل الكتاب.
ج ـ أداة الشرط «إذا» ومشكلة عدم الدلالة على تحقّق الشرط
إنّ الآية استخدمت أداة الشرط «إذا» وهي لا تفيد وقوع شرطها بالضرورة، فيكون المعنى أنّه لو قمنا بعملية نسخ في هذا القرآن لقالوا ـ بسبب جهلهم ـ: كذا وكذا، فليس في الآية أيّ إشارة وقوعيّة، بل الإشارة تقديريّة هدفُها الكشف عن جهلهم وما يتوقّع أن يقولوه، ثمّ تأكيد أنّه كتابٌ من عند الله. وعليه فكف نريد إثبات النسخ من خلال مقاربة افتراضية نقديّة قدّمها القرآن الكريم؟!
هذه الملاحظة قابلة للجواب أيضاً، فإنّ استخدام أداة الشرط في سياق وقوع أمر حصل وتحقّق مسبقاً، أمرٌ قائم في اللغة العرفيّة، دون أن يضرّ ذلك بالبناء الشرطي، وبخاصّة مع أداة الشرط “إذا” وليس “إن”، كما أفاد علماء اللغة، فعلى سبيل المثال يكثر أن يأتي زيدٌ إلى بيتك ومعه عمرو، فتقول أنت: إذا جاء زيد إلى بيتي اليوم فعمرو معه، فالجملة تقديريّة شرطيّة، لكنّ فكرتها واقعيّة، وهذا يعني أنّ هناك فرقاً بين ذات الجملة الشرطيّة، وبين كون الدلالة الإجماليّة ـ بقرينة السياق ـ كاشفة عن الوقوع المسبَق، وأنّ هذا البناء الشرطي منشؤه الوقوع المسبق المتكرّر. ويشهد لذلك هنا أنّ الآيات اللاحقة كشفت عن توجيه النبيّ كي يبيّن لهم أنّ هذا القرآن من عند الله، وأنّه نزل به الروح القُدس، فالآية لا تريد تقديم افتراضات خالصة لا خلفيّة وقوعية لها، بل تكشف في عمليّة الفرض عن واقع قائم بالفعل.
د ـ تفسير ابن بحر الاصفهاني المعتزلي لآية التبديل
ما يظهر من أبي مسلم الأصفهاني ـ القائل بامتناع النسخ ـ حيث نقل عنه الفخر الرازي قائلاً: «قد ذكرنا أنّ مذهب أبي مسلم الأصفهاني أنّ النسخ غير واقع في هذه الشريعة، فقال المراد ههنا: إذا بدّلنا آية مكان آية في الكتب المتقدّمة، مثل أنّه حوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال المشركون: أنت مفترٍ في هذا التبديل. وأمّا سائر المفسّرين فقالوا: النسخ واقعٌ في هذه الشريعة»[3].
فأبو مسلم اعتبر أنّ التبديل هنا شرائعي وليس داخل الشريعة الإسلاميّة، فكأنّ اليهود عندما كان يغيّر تشريعاتهم كانوا ينتقدونه بأنّ هذا افتراء منه، ولعلّه لهذا تمّ استخدام مفردة الروح القدس والتي لها حضور أيضاً في التراث اليهودي كالمسيحي، مع اختلافات في المفهوم تراجع في محلّها.
ولعلّه يمكن فرض تفسيرين لما ذهب إليه الإصفهاني ـ كما رجّحه الدكتور مصطفى زيد[4] ـ وهما:
التفسير الأوّل: ما تقدّم في كلمات الفخر الرازي، مما ظاهره أنّ المراد بالآية المنسوخة ـ وفقاً لكلام الإصفهاني ـ هو الآية من الكتب السماويّة السابقة، فالعلاقة بين آيتين: إحداهما في الكتب السابقة والثانية ـ وهي الناسخة ـ في القرآن الكريم. وهذا التفسير يحافظ على دلالة كلمة “الآية” غير أنّه يغيّر موضعها وينوّعه.
التفسير الثاني: ما يظهر من طريقة عرض القرطبي لمذهب أبي مسلم الإصفهاني، حيث قال: «قيل: المعنى بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة، قاله ابن بحر»[5].
والفرق بين التفسيرين أنّ استبدال شريعةٍ بشريعة لا يناسبه التعبير بتبديل آية بآىة؛ لأنّ الشريعة لا يطلق عليها تعبير “الآية”، وهو ما سجّله بعضهم نقداً هنا على الإصفهاني[6]، على عكس الآية من القرآن والآية من كتابٍ سماويّ سابق. وربما ـ وهذا مجرّد احتمال ـ لا يراد بعبارة القرطبي شيءٌ مغاير لمفاد نقل الرازي، فالشريعة هنا لا يراد منها المنظومة الكاملة، بل يراد ما شُرّع في السابق، فيصدق على المفرد والجمع معاً، والله العالم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجمع البيان 6: 135.
[2] النسخ في القرآن الكريم: 237.
[3] التفسير الكبير 20: 116؛ وسعيد الأنصاري، ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل: 65.
[4] النسخ في القرآن الكريم: 235 ـ 236.
[5] الجامع لأحكام القرآن 10: 176.
[6] انظر: النسخ في القرآن الكريم: 236 ـ 237.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القرآن والحياة في الكرات الأخرى
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
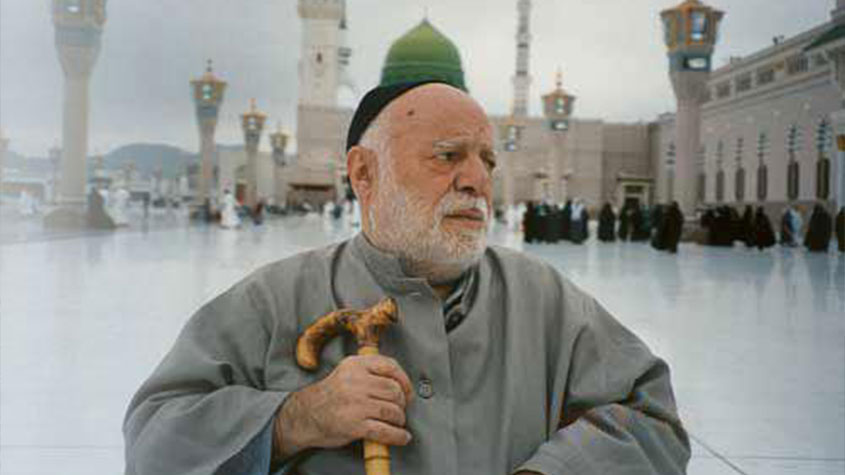 معنى (كدح) في القرآن الكريم
معنى (كدح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
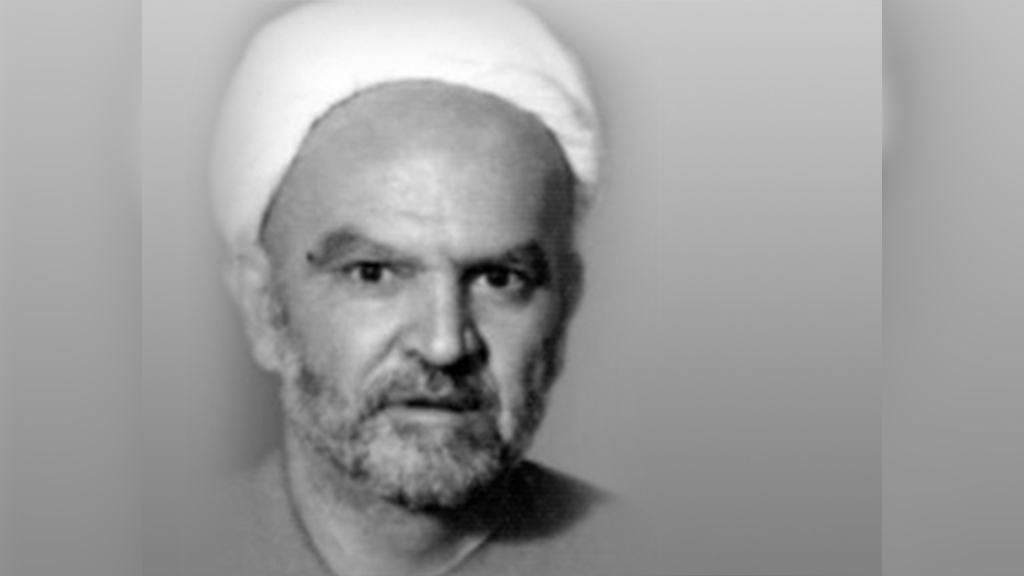 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
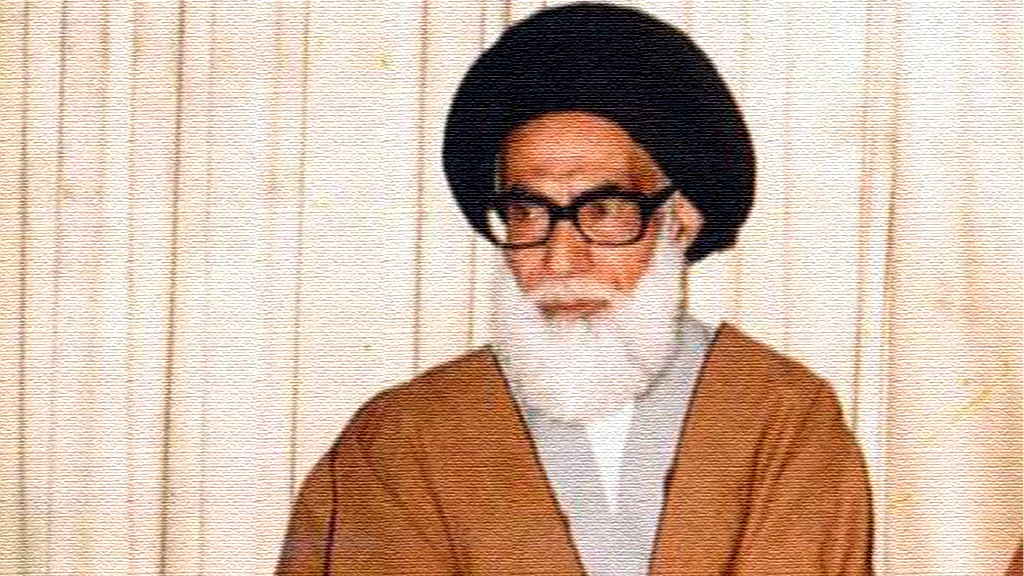 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
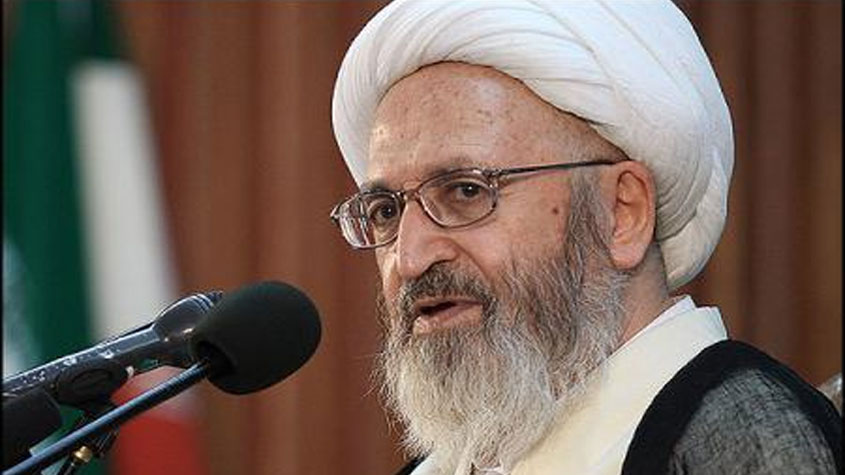 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
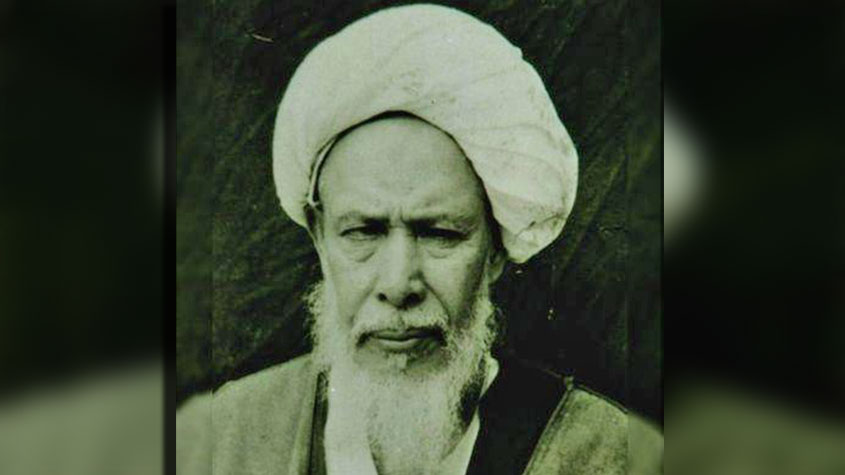 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

خلاصة تاريخ اليهود (2)
-
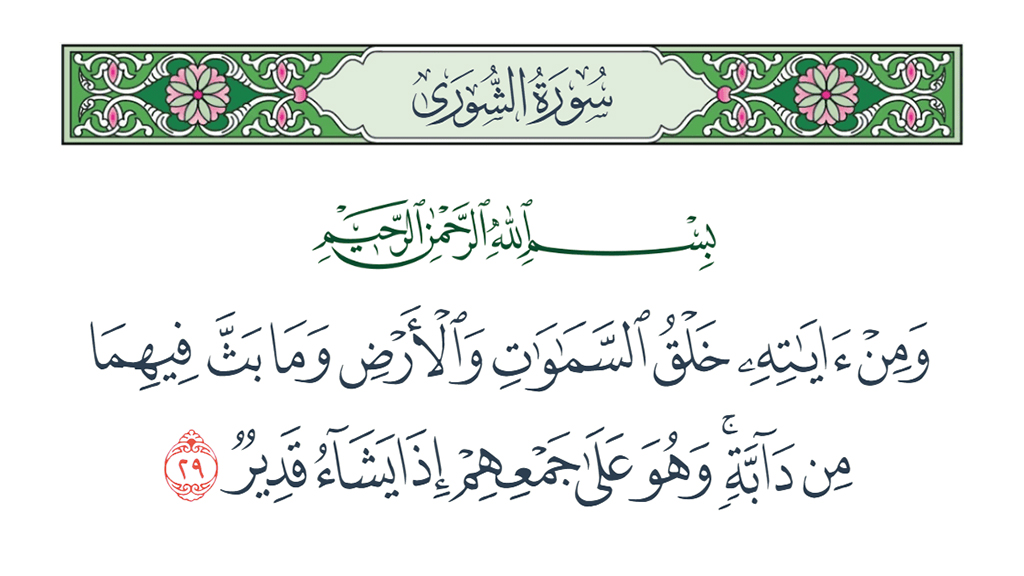
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
-
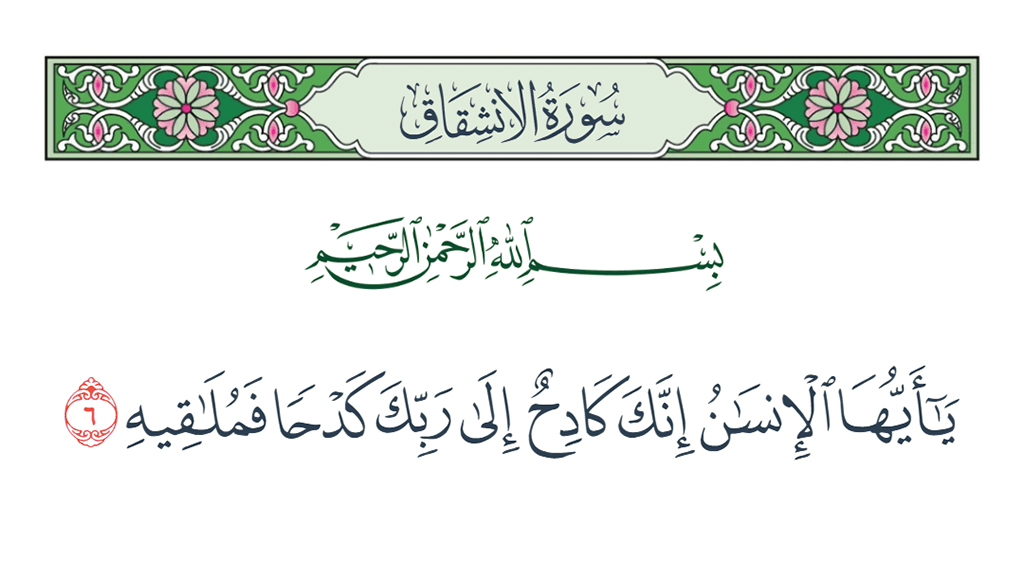
معنى (كدح) في القرآن الكريم
-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-
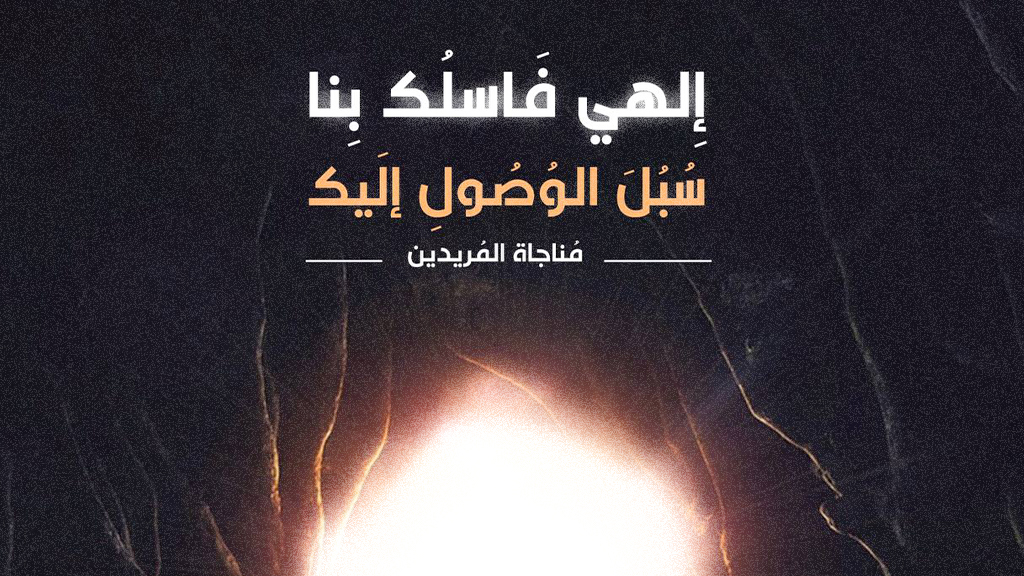
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-
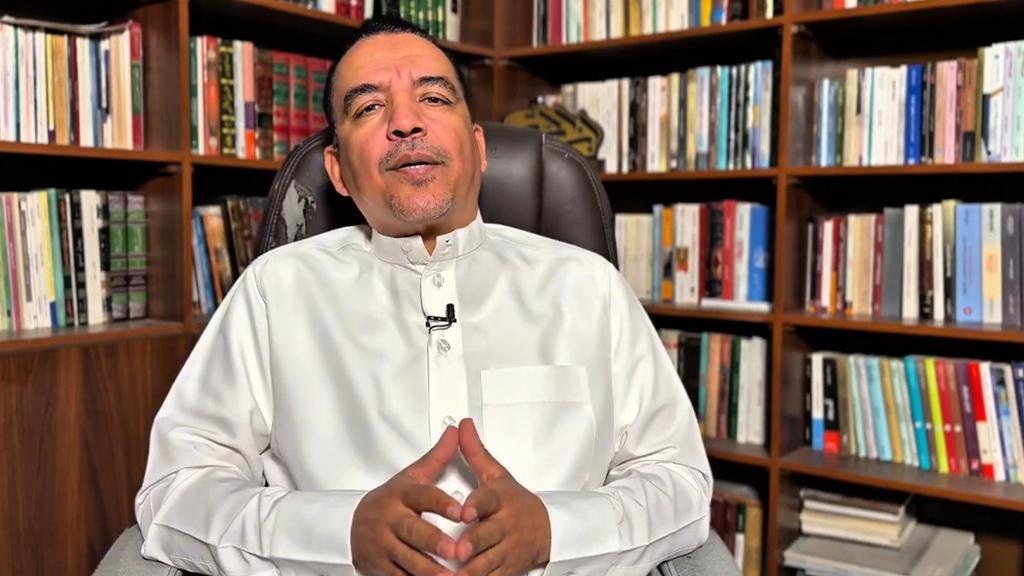
زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ