قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد صنقورعن الكاتب :
عالم دين بحراني ورئيس مركز الهدى للدراسات الإسلامية﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾
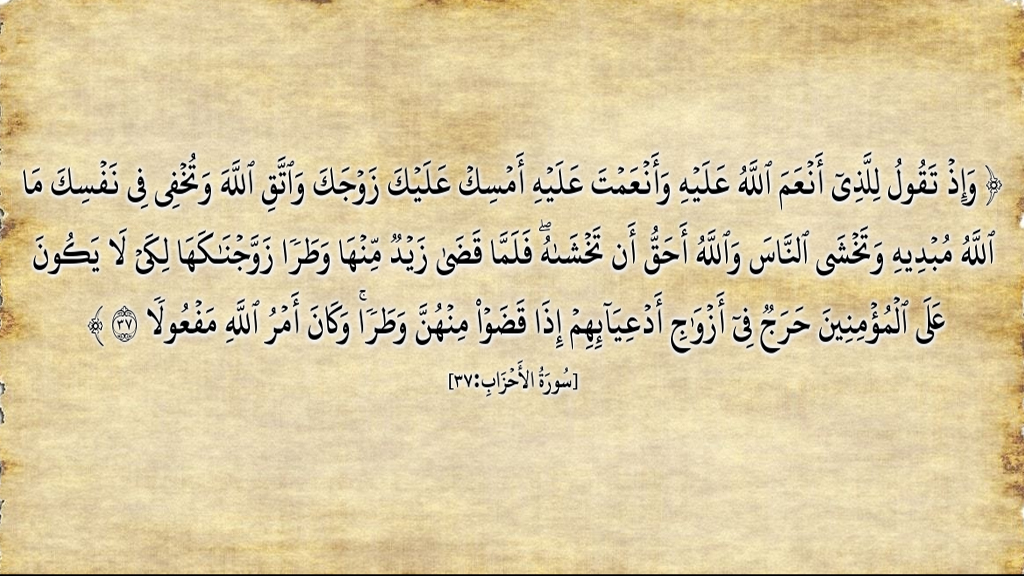
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ..﴾(1) عن أيِّ شيء تتحدَّث الآية ومَن المخاطَب بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ وما الذي كان يُخفيه النبيُّ (ص) في نفسِه فأبداه الله تعالى وأظهره للناس؟
الجواب:
الآيةُ المباركة تتحدَّثُ عن قضيَّة زيد بن حارثة وزوجتِه، فزيدُ بن حارثة رضوان الله تعالى عليه كان عبداً لرسول الله (ص) منذُ كان صغيراً فحرَّره النبيُّ (ص) وتبنَّاه ونسَبه إلى نفسه، أو نسَبَه الناس إليه، فكان يُدعى زيد بن محمد، فحين كبُر زوَّجه من ابنة عمَّته زينب بن جحش الأسديَّة والتي كانت أمُّها أُميمة بن عبد المطلب فهي ابنة عمَّته، خطبها النبيُّ (ص) لزيد وزوَّجها إيَّاه، وساقَ إليها المهر من ماله.
ويظهرُ من الآية المباركة، وكذلك بعض الروايات المتَّصلة بشأن نزول الآية أنَّ زيداً أراد الطلاق لزوجته زينب لأنَّه لم يكن بينهما توافق أو أنَّ ذلك وقع بعد زمنٍ من زواجهما، فكان يأتي النبيَّ (ص) ويُبدي له الرغبة في طلاق زوجتِه، وكان النبيُّ (ص) يمنعُه من الإقدام على طلاقِها ويأمرُه بالإمساك بها، ويأمرُه بتقوى الله تعالى، فلا يبعثه النزاع وعدم التوافق على الاجحاف بحقِّها في المعاشرة لها بالمعروف.
فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ بيانٌ لما كان يقولُه النبيُّ الكريم (ص) لزيدٍ حين يأتيه يشكو زوجتَه ويُبدي رغبته في طلاقِها، فكان يقول له: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ يعنى أنَّه (ص) كان ينهاهُ عن طلاقِها ويأمرُه بالإبقاء عليها في عُهدته، ويأمرُه في ذات الوقت بتقوى الله تعالى في معاشرتِها، فقوله: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ خطابٌ من النبيِّ الكريم (ص) لزيدِ، فزيدُ بن حارثة هو المخاطَب من قِبل النبيِّ (ص) بقوله: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾.
والمقصود مِن الذي أنعم اللهُ عليه وأنعمتَ عليه هو زيد بن حارثة والذي أنعم اللهُ عليه بالهداية والصلاح فكان من أوائل مَن أسلم وصدقَ في إيمانه وصبر وجاهد، وأنعم عليه رسولُ الله (ص) بتحريره من الرقِّ وتربيته والإحسان إليه وتبنِّيه بأن نسبَه إلى اسمِه قبل تشريع النهي عن ذلك عند نزول قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ / ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ..﴾(2) فبعد تشريع الأمر بنسبة المتبنَّى إلى أبيه الحقيقي أمرَ النبيُّ (ص) بأن يُسمَّى زيد باسم أبيه الحقيقي حارثة فسمِّي زيد بن حارثة بعد أن كان يُسمَّى زيد بن محمد.
ما الذي كان يُخفيه النبيُّ (ص) في نفسه؟
وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ فهو يُشير إلى أنَّه في الوقت الذي كان الرسول الكريم (ص) يأمرُ زيداً بالإمساك بزوجتِه وينهاهُ عن تطليقها كان يعلمُ أنَّ الله تعالى قد قضى بأنَّ زوجة زيد ستكون في المآل زوجةً له بعد طلاق زيدٍ لها، فكان النبيُّ (ص) يُخفي هذا الأمر حذراً من استهجان الناس لذلك، لأنَّ سيرتهم جرتْ على عدم تزوُّج الرجل من زوجة ابنِه بالتبنِّي، لأنَّهم يعتبرون الابن بالتبنِّي كالابن النسبي، فكما لا يسوغُ التزوُّج من زوجة الابن النسبي بعد طلاق الابن لها كذلك لا يسوغُ -بحسب عادتهم- التزوُّج من زوجة الابن بالتبنِّي بعد طلاقِه لها، فاقتضت إرادةُ الله تعالى إلغاء هذه العادة والتأكيد عمليَّاً على أنَّ الابن بالتبنِّي أجنبيٌّ، فيجوز الزواج مِن مطلَّقته تماماً كما يجوز الزواج من مطلَّقة أيِّ رجلٍ أجنبيٍّ آخر، لذلك قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾(3).
يعني فلمَّا قضى زيدٌ حاجته من زوجتِه وعزفتْ عنها نفسُه، فلم يعُد مُطيقاً للبقاء معها فأقدم على طلاقها، حينذاك وبعد انقضاء عدَّتها منه ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ يعني أمر اللهُ تعالى نبيَّه (ص) بالزواج منها ليكون ذلك فرجاً للمؤمنين، فلا يتحرَّجون من الزواج من زوجات أدعيائهم أي مِن زوجات أبنائهم بالتبنِّي بعد طلاقِهم لهن. فذلك هو أمرُ الله تعالى ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ ونافذاً. فالذي كان يُخفيه النبيُّ الكريم (ص) وأبداه اللهُ تعالى وأظهرَه هو أنَّ زينب بنت جحش -زوجةَ زيد- ستكون زوجةً له في المآل بعد طلاق زيدٍ لها وعزوفِه عنها.
وهنا يحسن بنا التنبيه على أمور:
بعض ما رُوي في سبب النزول والتعليق عليه:
الأمر الأول: قال علي بن إبراهيم -القمِّي- في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قال: فإنَّه حدَّثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سببُ نزول ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله لمَّا تزوَّج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارةٍ لها ورأى زيداً يُباع ورآه غلاماً كيِّساً حصيفاً فاشتراه، فلمَّا نُبِّأ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله دعاه إلى الاسلام فأسلم، وكان يُدعى زيد مولى محمَّد صلَّى الله عليه وآله، فلمَّا بلغَ حارثةَ بن شراحبيل الكلبي خبرُ ولدِه زيد قدم مكةَ، وكان رجلاُ جليلاً، فأتى أبا طالب فقال: يا أبا طالب إنَّ ابني وقع عليه السبي، وبلغني أنَّه صار إلى ابن أخيك، فسلْه إمَّا أنْ يبيعه، وإمَّا أنْ يُفاديه، وإمَّا أنْ يُعتقَه، فكلَّم أبو طالبٍ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله: هو حرٌّ فليذهبْ كيفَ يشاء، فقامَ حارثةُ فأخذَ بيد زيدٍ فقال له: يا بُني إلْحقْ بشرفِك وحسَبِك، فقال زيد: لستُ أفارقُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله أبداً، فقال له أبوه فتدعُ حسبَك ونسبَك وتكون عبداً لقريش؟ فقال زيدٌ لستُ أفارقُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله ما دمتُ حيَّاً، فغضبَ أبوه فقال: يا معشر قريش اشهدوا أنِّي قد برئتُ منه وليس هو ابني، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله: اشهدوا أنَّ زيداً ابني أرثُه ويرثُني، فكانَ يُدعى زيد بنُ محمد، فكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله يُحبُّه وسمَّاهُ زيدَ الحب.
فلمَّا هاجرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله إلى المدينة زوَّجه زينبَ بنت جحش، وأبطأ عنه يوماً فأتى رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله منزلَه يسألُ عنه، فإذا زينبُ جالسةٌ وسطَ حجرتِها تسحقُ طيباً بفهْرٍ، فنظرَ إليها، وكانت جميلةً حسَنَة، فقال: سبحانَ اللهِ خالقِ النور وتبارك اللهُ أحسنُ الخالقين، ثم رجع رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله إلى منزله ووقعتْ زينبُ في قلبِه موقعاً عجيباً، وجاء زيدٌ إلى منزلِه فأخبرتْه زينبُ بما قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله، فقال لها زيد: هل لكِ أنْ أُطلقَكِ حتى يتزوَّجَك رسولُ الله صلى الله عليه وآله فلعلَّكِ قد وقعتِ في قلبِه؟ فقالتْ: أخشى أنْ تُطلِّقني ولا يتزوَّجني رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله، فجاء زيدٌ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله فقال: بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله أخبَرتني زينبُ بكذا وكذا فهل لكَ أنْ أُطلِّقَها حتى تتزوَّجَها؟ فقال رسولُ الله: لا، اذهبْ فاتقِ الله وأمسِك عليك زوجَك، ثم حكى الله فقال: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا -إلى قوله- وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ فزوَّجه اللهُ من فوقِ عرشِه .."(4).
التعليق على الرواية:
أقول: أمَّا صدرُ الرواية إلى قوله: "فلمَّا هاجرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله إلى المدينة زوَّجه زينبَ بنت جحش" فهو قابلٌ للقبول، وقد ورد ما يقربُ منه في رواياتٍ أخرى، وأمَّا ما جاء في الرواية بعد هذا المقدار فهو -دون ريبٍ- مكذوبٌ ومن وضع الوضَّاعين الذين دأبوا على دسِّ الكذب خِلسةً بغية التنقُّصِ والنيل من المقام السامي للرسول الكريم (ص).
فما ورد في الرواية من أنَّ النبيَّ الكريم (ص) دخل بيت زيد دون استئذان ولا إشعار فوجد زينب جالسةً وسط حجرتِها وبطبيعة الحال لم تكن محتشمة لذلك اطَّلع على محاسنها، مثلُ هذا الفعل لا يصدرُ من ذوي المُروءات فضلاً عمَّن عصمَه الله تعالى عن الزلل، ثم إنَّ مَن اختلق هذه الفِرية لم يكتفِ بهذا المقدار -رغم كونِه عظيماً وشنيعاً -بل زعم أنَّ النبيَّ الكريم (ص) تكلَّم بما فيه غزل وتشبيبٌ بامرأةٍ أجنبيَّة وذاتِ بعل فأسمعَها ما لا يسوغ لمؤمنٍ أنْ يُسمعَه امرأةً هي في حبالةِ غيره.
ثم افترى فِريةً ثالثة فزعم أنَّ زينبَ وقعتْ من نفس النبيِّ الكريم (ص) موقعاً عجيباً، أراد من ذلك القول إنَّ ما عناه القرآنُ من قوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ هو أنَّ النبيَّ (ص) أخفى عشقَه وإعجابه بزينب وهو خلافُ الواضح من مدلول الآيةِ المباركة وأنَّ الذي كان يُخفيه النبيُّ (ص) هو ما أخبره اللهُ به من أنَّ زينب ستكون زوجةً له بعد طلاق زيدٍ لها.
ويدلُّ على ذلك أنَّ الآية أفادت أنَّ الله سيُبدي ويُظهرُ ما أخفاه النبيُّ (ص) ثم لم تُبدِ أكثر من أنَّ الله تعالى قد زوَّجه زينب بعد أنْ قضى زيدٌ منها وطراً، ومعنى ذلك أنَّ الذي كان يُخفيه النبيُّ (ص) -رعاية لنفسية زيد وحذراً من إرجاف المنافقين-هو أنَّ الله قد قضى بأن تكون زينب زوجةً له بعد طلاق زيدٍ لها. قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فالذي أظهرته الآية هو أنَّ الله قد زوَّج النبيَّ (ص) من زينب، فلو كان ما أخفاهُ النبيُّ (ص) هو العشق والإعجاب- كما زعم صاحب الفِرية- لكان معنى ذلك أنَّ الآية لم تُبدِ ما أخفاه النبيُّ(ص) وإنَّما أبدتْ شيئاً آخر، فالنبيُّ (ص) قد أخفى عشقه وتعلٌّقه بزينب -بحسب زعم صاحب الفرية- وما أبدته الآية هو أنَّ الله قد زوَّجه من زينب، ولم تتحدَّث عن العشق والإعجاب، فلم تفِ الآية -بحسب زعم صاحب الفرية- بما وعدتْ به من إبداء ما أخفاهُ النبي(ص)!!.
والذي يؤكِّد أنَّ ما عناه القرآن من قوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ هو ما قضاه اللهُ من تزويجه بزينب وليس هو العشق والإعجاب، الذي يؤكِّد ذلك ما رُوي عن الإمام زين العابدين (ع) من: "أنّ الَّذي أخفاهُ في نفسه هو أنّ اللَّه سبحانه أعلمَه أنَّها ستكون من أزواجه"(5) وروى نحوَ ذلك الطبريُّ في جامع البيان بسنده عن الإمام زين العابدين(ع)(6)
وروى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا(ع) بسنده عن الإمام الرضا (ع) في سياق جوابه عن أسئلة عليِّ بن الجهم حول عصمة الأنبياء قال (ع): ".. وأمَّا محمَّد (صلى الله عليه وآله) وقول الله تعالى: ﴿وتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّه مُبْدِيه وتَخْشَى النَّاسَ واللَّه أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه﴾ فإنَّ الله تعالى عرَّف نبيَّه (صلَّى الله عليه وآله) أسماءَ أزواجه في دار الدنيا، وأسماء أزواجِه في دار الآخرة، وأنَّهن أمهاتُ المؤمنين. وإحداهن -من سمَّى له-: زينب بنت جحش، وهي يومئذٍ تحت زيد بن حارثة، فأخفى رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله) اسمَها في نفسه، ولم يبده، لكي لا يقول أحدٌ من المنافقين إنَّه قال في امرأةٍ في بيت رجلٍ إنَّها إحدى أزواجِه من أمهات المؤمنين، وخشي قول المنافقين، فقال الله تعالى: ﴿وتَخْشَى النَّاسَ واللَّه أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه﴾ يعني في نفسك، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ ما تولَّى تزويج أحدٍ من خلقِه إلا تزويج حواء من آدم (عليه السلام) وزينب مِن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله: ﴿فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها﴾ الآية، وفاطمة من عليٍّ (عليهما السلام) .."(7)
النبيُّ (ص) لم يكنْ يرغبُ في الزواج من زينب:
الأمر الثاني: إنَّ النبيَّ الكريم (ص) لم يكنْ يرغب أساساً في الزواج من زينب بنت جحش، ولم يكن من عزمه فعل ذلك فهو (ص) مَن اختارها لزيدٍ وخطبَها له وعزم عليها وعلى أخيها عبد الله بن جحش أنْ يقبلا بزيد زوجاً، وحين امتنعت أو تلكَّأت وتلكَّأ أخوها نزل -كما في الروايات(8)- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ومؤدَّى ذلك أنَّ الرسول (ص) قد عزم على زينب وأخيها أن يقبلا بزيد زوجاً وأنَّ عدم القبول يُعدُّ معصية لله وللرسول (ص) وهو من الضلال المبين، لذلك قبلت زينب بزيدٍ وقبله عبدُ الله بن جحش زوجاً لأخته امتثالاً لأمر الرسول (ص).
فالنبيُّ (ص) لم يكن مُريداً للزواج من زينب، ولو كان مريداً للزواج منها ابتداء لرحَّبت بذلك واستبشر أهلُها لكنَّه لم يفعل فهي ابنة عمَّته ويتشرفون كما يتشرَّف كلُّ أحدٍ بمصاهرته، ودعوى أنَّه لم يكن يعلم بحُسنها لا تصحُّ فقد كان بوسعه الوقوف على ذلك من طريق النساء لكنَّ ذلك لم يكن يشغلُه، فهو إنَّما تزوَّجها بعد طلاق زيدٍ لها لأنَّ الله تعالى قد فرض عليه ذلك لغايةٍ بينتها الآيةُ، قال تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ فاللهُ جلَّ وعلا قال: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ أي فرض عليه الزواج منها ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ وتصدَّت الآية لبيان الغاية من ذلك، فلم تكن الغاية هي رغبة النبيِّ(ص) في الزواج منها بل الغاية هي: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ فالغاية هي الإلغاءُ العملي للعادة الجارية منذ أيام الجاهليَّة على عدم التزوُّج من مطلَّقة الابن بالتبنِّي، فحين يُقدِم النبيُّ (ص) على الزواج من مطلَّقة ابنِه بالتبنِّي يكون ذلك أوقعَ في إلغاء هذه العادة، وينتفي به الحرج عن المؤمنين لو أقدموا على الزواج من مطلَّقاتِ أبنائهم بالتبنِّي، إذ لا مساغ للطعن عليهم بعد إقدام النبيِّ (ص) على ذلك، فإقدام النبيِّ الكريم (ص) على الزواج من زينب بعد طلاق زيدٍ لها كان إيثاراً منه وتضحيةً، لأنَّه سيقعُ من ذلك في حرجٍ، كونه أول من سيكسر هذه العادة فيكون بهذا الزواج مرمى لسهام المنافقين واستغراب المتذبذبين، فإقدامُه على الزواج من مطلَّقة ابنه بالتبنِّي كان إيثاراً منه يرتفع به الحرجُ عن المؤمنين إذا أقدموا بعد ذلك على الزواج من مطلَّقات أدعيائهم كما هو مفاد الآية، فلم يكن ذلك عن رغبةٍ منه ويؤكِّده قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ فمؤدَّى هذه الفقرة من الآية هو أنَّ النبيَّ (ص) لم يكن مِن رغبته الإقدام على هذا الزواج لولا أنَّ الله تعالى قد فرض عليه ذلك. لكسر هذه العادة وضبط المواريث والمحارم، والمحاذرة من وقوع الاختلاط في الأنساب.
كيف يخشى الناس والأنبياء لا يخشون أحداً إلا الله؟
الأمر الثالث: قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ كيف تنسب الآية الخشية من الناس للرسول الكريم (ص) وقد قال الله تعالى في آيةٍ أخرى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾(9).
مقتضى الجمع بين الآيتين -كما هو المستفاد من كلمات السيِّد الطباطبائي(10)- هو أنَّ المراد من خشية الناس هو الخشية من أنْ يتَّخذ المنافقونَ من إقدامه على الزواج من مطلَّقة زيدٍ مدخلاً للطعن عليه والإرجاف بذلك في أوساط العامَّة والبسطاء من الناس، فيكون ذلك منشأً لإساءتهم الظنَّ به وانبعاث الشكِّ والارتياب في نفوسهم، فكان يخشى من ذلك على إيمان الناس من أنْ يشوبُه شك أو ارتياب فيسوقهم ذلك إلى الضلال، فهي إذن خشية في الله ومن أجل الله تعالى، ولهذا فمثل هذه الخشية ليست مذمومة بل هي محمودة وباعثها الحرص الشديد على إيمان الناس وثباتِهم على الهداية، وبخلاف ذلك الخشية التي نفتها الآية عن الذين يبلِّغون رسالات الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ فالخشية المنفية عن الأنبياء في هذه الآية هي الخشية من شرور الناس وعدوانهم وضررهم، فالأنبياء لا يخشون أحداً يعنى أنَّهم لا يرهبون أحداً، ولا يساورهم شعور بالخوف من أحدٍ وإنْ تعاظمت قوتُه وسطوتُه وطغيانُه.
ثم إنَّ الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ وإنْ سِيقت في صورة العتاب للنبيِّ الكريم (ص) ولكن الغرض من ذلك هو التقريع والتشنيع على مَن سيتَّهم النبيَّ (ص) ويطعنُ عليه بأنَّه تزوَّج مِن مطلقة ابنه، وكذلك الغرض منه الردع لمَن سيقع تحت تأثير إرجافهم، فمؤدَّى ما ترمي إليه الآية هو أنَّ ما فعلتَه يا رسول الله وأقدمتَ عليه من الزواج من مطلَّقة زيد كان بأمرِنا فلا مساغ لأحدٍ في الطعن والاستهجان وإساءة الظن.
فمساق الآية المباركة يُشبه مساق قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾(11) فالآية وإنْ سيقت في صورة العتاب للنبيِّ الكريم (ص) ولكنَّ الغرضَ من سوقها بهذا النحو هو إفادة أنَّ هؤلاء لا يستحقُّون الإذن وليسوا صادقين فيما أبدوه من أعذار. تماماً كما في مثل قول أحدهم لمَن عفى وصفح عمَّن ظلمه وأوغل في الإساءة إليه: لِمَ عفوتَ عنه؟! فالغرض هذا العتاب ليس هو التوبيخ للمخاطَب وإنَّما الغرض ذلك إفادة أنَّ هذا لا يستحقُّ العفوَ والصفح.
كذلك هو الشأن في قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ فإنَّ مؤدَّى ما يرمي إليه هو إفادة أنَّ ما فعلتَه كان بأمرنا، فلا مساغ للطعن من أحدٍ عليك، فالآية مسوقة في صيغة العتاب ولكن الغرض منها سدُّ الباب على المنافقين قبل أن يشرعون في الطعن على النبيِّ الكريم (ص) لأنَّ مفادها أنَّ ما فعله النبيُّ (ص) كان بأمر الله تعالى ولهذا لا مساع للطعن عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سورة الأحزاب / 37.
2- سورة الأحزاب / 4-5.
3- سورة الأحزاب / 37.
4- تفسير القمي -علي بن إبراهيم القمي- ج2 / ص172-173.
5- تفسير مجمع البيان- الطبرسي- ج8 / ص162.
6- جامع البيان -محمد بن جرير الطبري- ج20 / ص274.
7- عيون أخبار الرضا (ع) -الصدوق- ج1 / ص173.
8- روى ذلك الطبرسي في مجمع البيان قال: نزلت في زينب بنت جحش الأسدية، وكانت بنت أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مولاه زيد بن حارثة، ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت، وقالت: أنا ابنة عمتك، فلم أكن لأفعل. وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحش فنزل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية. يعني عبد الله بن جحش، وأخته زينب. فلما نزلت الآية، قالت: رضيت يا رسول الله، وجعلت أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، فدخل بها، وساق إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة دنانير، وستين درهما مهرا وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا، وخمسين مدَّاً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقالت زينب: خطبني عدة من قريش، فبعثت أختي حمنة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستشيره، فأشار بزيد، فغضبت أختي، وقالت: تزوج بنت عمتك مولاك. ثم أعلمتني، فغضبت أشد من غضبها، فنزلت الآية. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت: زوجني ممن شئت. فزوجني من زيد. ج8 / ص161.
9- سورة الأحزاب / 39.
10- الميزان في تفسير القرآن -السيد الطبأطبائي- ج16 / ص322.
11- سورة التوبة / 44.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القرآن والحياة في الكرات الأخرى
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 معنى (كدح) في القرآن الكريم
معنى (كدح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

خلاصة تاريخ اليهود (2)
-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى
-

معنى (كدح) في القرآن الكريم
-
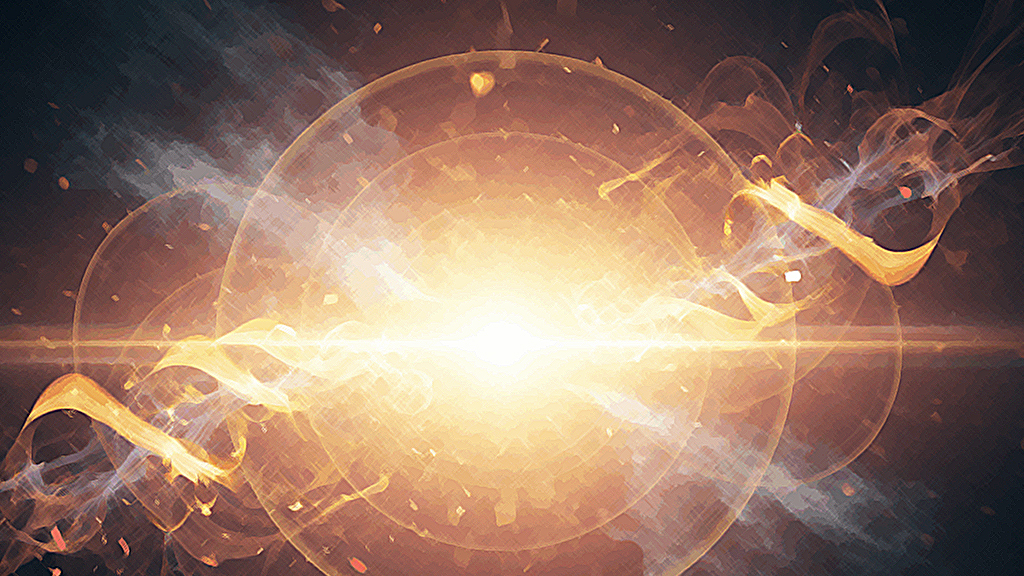
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-
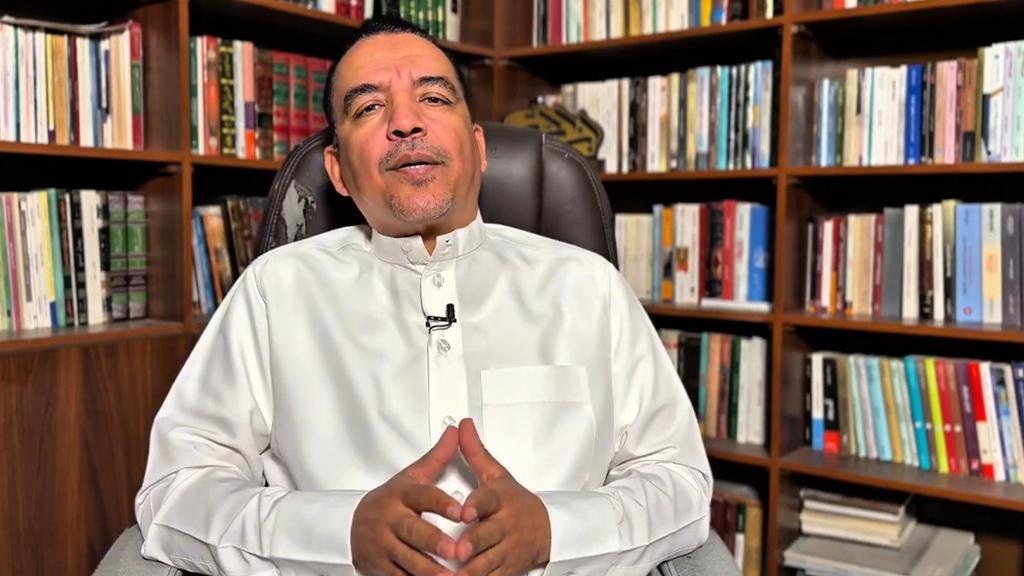
زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ










